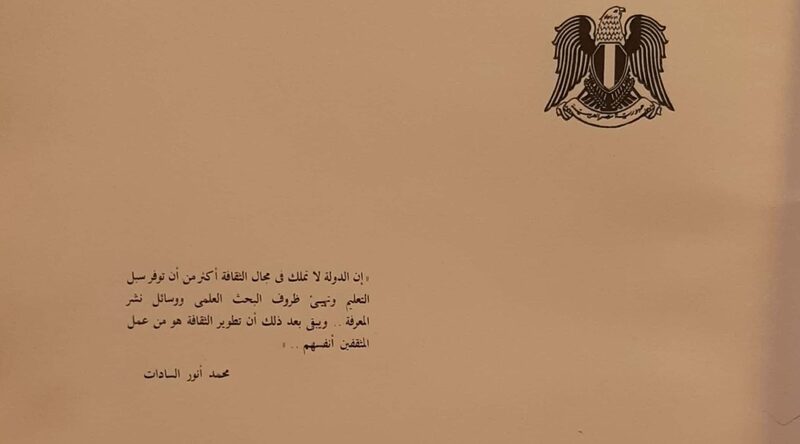إذا بحثت في المعجم ستجد أن الجائزة هي: مقدار الماء الذي يجوز به المسافر من مَنهل إِلى منهل.. لكن هذا التعريف تحول وتحور حتى صار له معان مختلفة تمامًا الآن.. خصوصًا لو كان الحديث عن جوائز تحدد المكانة وتؤكد الاستحقاق، وتترجم إلى مبلغ كبير من المال يتلقاه الفائز، المميز، المستحق. الذي يسعد، وتزداد ثقته بما يقدمه، ويندفع لإكمال ما بدأه بروح قوية.. لكن يوجد جانب آخر؛ حيث الخاسر الذي يرى أنه مستحق، وأنه تعرض لظلم..
منذ ما يقرب من قرن بدأت الدولة، انطلاقًا من سلطاتها، الحقيقية والمتوهمة، باعتبارها لنفسها الحكم الأول، في منح جوائز رسمية في مختلف المجالات، الآداب والفنون والعلوم وغيرها، وأسمتها ببساطة “جوائز الدولة”. لكن بساطة التسمية لم تنسحب على بقية التفاصيل، التي ازدحمت بحسابات تخص الولاء والانتماء، ومكافأة المقربين، ومعاقبة المختلفين، لكن لا شك أنه بعد كل هذه الفترة الطويلة، كان هناك مستحقون نالوا تقديرًا منتظرًا، وفي المقابل منحوا تلك الجوائز بعض مصداقية، تهتز من حين إلى آخر كبندول الساعة.
في يونيو من كل عام تعلن جوائز الدولة، ويثور الجدل الموسمي، وتطرح الأسئلة، وتنهال التهاني والمباركات، ثم ينفض المشهد. لكن هذا ليس كل شيء.. لذا قررنا العودة والبحث مع ناصر كامل في أصل الحكاية.

الصورة كانت ضمن حصيلة البحث عن حافظ عفيفي (باشا)؛ الذي أرسل اقتراحًا بتدشين جائزة باسم فاروق الأول.. الصورة حسب الموقع الذي نشرها من عزبة حافظ عفيفي وهو بالطبع الواقف جهة اليسار
٠٠فكرة صاحب السعادة
قد تكفي الوقائع الغفل، وحدها، كمرشد في طريق البحث عن أصل الداء الذي ظهرت “كارثية” آثاره الجانبية في العديد من مناحي الحياة الثقافية المصرية المعاصرة، ونقاط تماسها المباشرة مع الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنها تظل قاصرة عن إنتاج معنى، أو دلالة، فذلك يحتاج بحث أعمق وأشمل.
بداية التفكير في جوائز الدولة تعود إلى أكثر من ثمانين عامًا، ويمدنا أرشيف مجلة “الرسالة” الأسبوعية، بالعديد من العلامات، الأولى المتعلقة بالفكرة، فبعد بضعة أشهر من تولي الملك فاروق الأول لسلطاته الدستورية (29 يوليو 1937) “أرسل حضرة صاحب السعادة الدكتور حافظ عفيفي “باشا” وزير مصر المفوض في لندن إلى وزارة المعارف مذكرة يقترح فيها إنشاء جائزة مالية سنوية باسم (فاروق الأول) تمنح للمصريين المتفوقين في العلوم والآداب والفنون”.
في نفس العدد نشرت “الرسالة” أخبارًا تبدو متصلة بصورة ما بالاقتراح ومؤيدة له، فهناك متابعة خبرية لجوائز نوبل، وتركيز على خبر فوز الكاتب الفرنسي روجيه مارتان دوجار بجائزة نوبل للآداب، التي وصفها المحرر بأنها “في الواقع أشهر جوائز نوبل”، وآخر بعنوان “كيف يشجعون الآداب والفنون”: “وآخر ما انتهى إلينا من ذلك أن هبة جديدة قدرها مليون كرون (نحو 55 ألف جنيه) قد رصدتها دار النشر السويدية الشهيرة (ألبرت بونير) لتشجيع المؤلفين والفنانين، وذلك لمناسبة الاحتفال بعيدها المئوي”، ويعلق المحرر: “أما في مصر فإن الآداب لم تنل حتى اليوم تقديرًا ولا تشجيعًا، لا من الجهات الرسمية، ولا من رجال المال؛ وما زالت فكرة الجوائز الرسمية لتشجيع التأليف تتردد منذ أعوام بين اللجان والجهات المختلفة دون أن تحظى بالتنفيذ العملي”.
صاحب فكرة جوائز “الدولة”، أو للدقة أول من أعلن عنها، حافظ باشا عفيفي (1886- 1961) من الشخصيات المؤثرة في الكثير من مجالات الحياة في مصر، فهو: طبيب أطفال شهير(أسس فور تخرجه في «مدرسة الطب» في عام ١٩٠٧جمعية أهلية “جمعية رعاية الأطفال المصرية”، التي أنشأت أول مستشفى أطفال “أبو الريش للأطفال”، في نفس المكان الذي يشغله الآن المستشفى الشهير)، لكنه عُرف أساسًا كسياسي ودبلوماسي واقتصادي، فقد تولي وزارة الخارجية (1928)، وكان آخر من تولي منصب رئيس الديوان الملكي (يناير 1952)، وكان له ميل وانحياز واضح لإنجلترا، وعبر عن ذلك في كتابه «الإنجليز في بلادهم»، وفيما يتعلق بموضوعنا مباشرة ستكون لجملته هذه أهمية خاصة: “لا شكَّ أن النظم الدستورية قد أصابتها في العهد الأخير أزمة خطيرة وهذه الأزمة ليست وليدة الحرب الحاضرة (الحرب العالمية الثانية 1939- 1945) أو الحوادث السياسية التي سبقتها، ولكنها ترجع إلى ما قبل ذلك بأعوام عديدة، كما أنها ترجع إلى عوامل أعمق وأبعد أثرًا، ومن المسلَّم به أيضًا أن الحكم النيابي قد فشل في كثير من البلاد الديمقراطية، وإن كان هذا الفشل لا يرجع إلى أسس الحكم الدستوري ذاتها، وإنما يرجع إلى الوسائل التي طُبِّقت بها، وإلى أن النظم الدستورية قد انحرفت في هذه البلاد عن طريقتها ومبادئها الأصلية، ولم يبقَ منها سوى المظاهر الشكلية؛ وبذلك فقدت كثيرًا من صلاحيتها للحكم وقيادة الشعوب”.
هذه الجملة تعبير عن اتجاه قوي “أصيل” داخل قطاع عريض من النخبة السياسة المصرية في العقود الثلاثة التي أعقبت ثورة 1919، قطاع يرى أن الديمقراطية وحرية الرأي والأحزاب والحياة البرلمانية كلها ممارسات لا تناسب الواقع المصري، وحافظ باشا يمد بدليل إضافي ناقد بصورة قطعية للتجربة في ذروة تجلياتها. وظل الاقتراح متداولاً لنحو عقدين، حتى شكل إسماعيل صدقي (1875 – 1950) حكومته الثالثة في عام 1946، فصدر المرسوم الملكي بإنشاء جوائز فؤاد الأول وجوائز فاروق الأول، لكن الوزارة تغيرت بعد نحو شهرين من صدور المرسوم، وانتظر البحث في تنفيذه حتى شكل فهمي النقراشي وزارته الثانية، وجاء عبد الرزاق السنهوري وزيرا للمعارف العمومية، ووجدت الوزارة أن المرسوم الصادر في بداية الخريف ظل يثير تساؤلات، وينتج صراعات، تراكمت حتى جاء ربيع 1947 ومعه تعديل على المرسوم بمرسوم جديد، والتعديل وضع “ضوابط” وشروط، فالجوائز الست السنوية التي تسمي جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول، وتكون قيمة كل منها 1000 جنيه مصري، وتمنح لصاحب أحسن عمل أو إنتاج في الآداب والقانون والعلوم، يكون استحقاقها وفقًا لشروط، حددها مرسوم “الربيع”، وأن القائم على تنفيذ المرسومين هو وزير المعارف العمومية.
قبل أن نذهب للجدل الجديد سيكون مهما ملاحظة عدة مسائل متعلقة بحكومة صدقي وخطته الوزارية التي صدر في ظلها مرسوم الجوائز، ففي مذكراته يدلنا “صدقي” على موقفه السياسي الجذري: “إن النظام الحزبي- وهو وليد النظام البرلماني- كان في رأيي مما يصرف أداة الحكم عن كليات الأمور إلى جزئياتها، وذلك بسبب اشتغال الأحزاب بما يهم كيانها قبل اشتغالها بمصلحة المجموع”، وهو موقف ينسجم تمامًا مع ما تقدم وعرفناه عن رأي صاحب مقترح الجوائز.
جاء في افتتاحية “الرسالة”؛ التي كتبها صاحبها “أحمد حسن الزيات”، بعد نحو شهر من تشكيل صدقي لحكومته، أن: “الوزارة الصدقية (نسبة لصدقي) محدودة الأجل بنتيجة المفاوضات، فإذا أخفقت مفاوضة الاحتلال، أو مال ميزان الانتخابات إلى الشمال، اعتزلت الوزارة الحكم لا محالة. وإذن يحق لنا أن نتساءل عن مصير العملين العظيمين اللذين بدأهما صدقي باشا؛ فأما المفاوضات السياسية فسيستأنفها وفد يتلوه وفد إلى أن يرث الله الجزر البريطانية ومن عليها، لأن هذا النوع من الجهاد كلام ونحن نجيده، وسلام ونحن نريده. وأما هذه الهبة الإصلاحية فأغلب الظن ألاَّ تستمر”. وهنا، إذن، حضور لأربعة ملفات: رؤية سياسية تنظر بغضب للحريات العامة والحياة الحزبية والانتخابات والبرلمان، وقضية “وطنية”: الاستقلال والجلاء، ومسائل اجتماعية، ومسعى ثقافي. وقد رُحلت إلى وزارة جديدة، وظهرت الصراعات والتقاطعات بصورة كاشفة.

الدكتور محمد حسين هيكل
٠٠”المعذبون” في الجائزة
في 28 أبريل 1947، يوم ذكرى وفاة الملك فؤاد الأول، أقيم الحفل الأول لتوزيع الجوائز، وفيه ظهرت بذرة “الحجب” بأوضح وأشد صورها تعبيرًا عن أزمة الثقافة المصرية المعاصرة وعلاقتها المعقدة بالدولة، فقد أعلن أحمد لطفي السيد “باشا”، رئيس لجنة الفحص لجوائز الآداب أن اللجنة لم تفرغ من عملها بعد ولهذا قررت إعلان تأجيلها إلى العام القادم، بينما أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز القانون والعلوم. وتزيدنا “الرسالة” معرفة: “بعض الصحف علقت بكلام كثير في هذا الشأن وزعمت أن الأدباء الذين تقدموا لنيل الجائزة لم يستحق أحد منهم الفوز بها”، ثم تكشف في العدد التالي عن المزيد: “كاد يسكن ذلك الغبار لولا أن أثاره عاليًا كثيفًا الأستاذ عباس محمود العقاد في مقال، نشرته (أخبار اليوم)، عنوانه “علامة الاستفهام في قرار لجنة الآداب” وجه فيه الأستاذ الكبير النقد إلى تصرف اللجنة لأنها قبلت العمل وأجابت الدعوة وهي تعلم الموعد المقرر وتعلم المهمة المطلوبة، وتساءل: (ولماذا لم تتنح عن العمل منذ اللحظة الأولى إذا كانت قد علمت أنها لا تستطيع الوصول فيه إلى نتيجة؟)”.
و في كتابه “حياتي” يذكر أحمد أمين بعض ملابسات تأجيل جائزة الآدب “أُجل منح الجائزة في السنة الأولى فلما أتت السنة الثانية كان لدى اللجنة ألفا جنيه اتفق الأعضاء على منح إحدى الجائزتين للأستاذ عباس العقاد، واختلفوا في الجائزة الثانية بيني وبين الدكتور محمد حسين هيكل واشتد النزاع بين الرأيين ولم يعدل أحد الفريقين عن رأيه، ثم تقررت ألف ثالثة ومنحت الثلاثة آلاف أول ما منحت للأستاذ عباس محمود العقاد والدكتور هيكل وأحمد أمين بالتساوي، كلُّ منح ألفا وانتهى بذلك الإشكال الذي استمر طويلاً”. و”الإشكال” كما يصفه أحد الفائزين بالجائزة، به الكثير من الإشارات إلى طبيعة الصراع الحاد للغاية حول الجوائز، صراع ذو طبيعة سياسية واجتماعية وثقافية، فوزارة النقراشي وزارة حزبية بالكامل تألفت من ممثلين عن حزب الأحرار الدستوريين والحزب السعدي، المنافسين لحزب الوفد صاحب الشعبية الجارفة، وبهذا تتولد شكوك كبيرة حول “النزاهة” في دخول الدكتور “هيكل” المنافسة، ومن ثم نيل الجائزة، فالدكتور محمد حسين هيكل، كان نائبًا لرئيس حزب الأحرار الدستوريين، ورئيسًا لمجلس الشيوخ، وقبل كل هذا فقد كان أحد أعضاء لجنة الفحص لجائزة فؤاد الأول للآداب عن سنة 1947، وبعدما تأجل منح الجائزة تشكلت لجنة فحص جديدة، وبذلك دخل ضمن قائمة المتباريين لنيل الجائزة.
ستكون سابقة الدكتور هيكل تلك المنارة التي تهدي اللجان وهي تمنح خلفاءه في رئاسة المجالس النيابية في العهود الجمهورية التالية جوائز الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وليس في الآداب بالطبع، فلم يصبهم منها شيئًا. وجانب آخر من التباسات البداية يوضحه جلال أمين في كتابه “ماذا حدث للثقافة في مصر؟”، فهو يقارن ما قبل يوليو 1952، وما بعده، ويخلص إلى أنه “لا يستطيع أحد أن يزعم أن حياتنا الثقافية قبل ثورة 1952 كانت خالية من الظلم، فمن الذي يستطيع أن يزعم ذلك لأي بلد في أي عصر؟ ولكن الحقيقة هي أن الظلم قبل 1952 كان أقل منه بعدها. من الأمثلة التي أذكرها لهذا الظلم في عهد الملكية، رفض الملك فاروق (أو بالأحرى القصر الملكي) أن تمنح جائزة الملك فؤاد الأول للآداب (وهي التي سميت جائزة الدولة التقديرية بعد سقوط الملكية) للدكتور طه حسين في 1947، على الرغم من أنه كان بلا شك أكبر اسم في الحياة الثقافية المصرية في ذلك الوقت. سمعنا وقتها أن الملك غاضب من كتاب نُشر لطه حسين، قبل ذلك بقليل، بعنوان “المعذبون في الأرض”، ويندد فيه بحالة الفقر في مصر. ومع ذلك فإن هذا الغضب لم يمنع طه حسين من اعتلاء منصب وزير المعارف بعد ذلك بثلاث سنوات، عندما أتت انتخابات برلمانية نزيهة بمصطفى النحاس رئيسًا للوزراء، وشكل حكومته الوفدية في 1950”.
نشر طه حسين أول قصة في سلسلة “المعذبون في الأرض” في مجلة “الكاتب المصري”؛ التي كان يرأس تحريرها، في يناير 1946، وقد قدم لها بهذا الإهداء: إلى الذين يحرقهم الشوق إلى العدل، وإلى الذين يؤرقهم الخوف من العدل، إلى أولئك وهؤلاء جميعًا، أسوق هذا الحديث”. جمع طه حسين القصص المنشورة في “الكاتب المصري”، مع أخرى نشرها في مجلات وصحف مصرية أخرى، وسعي لنشرها في كتاب، لكنه لم يوفق إلى ذلك في مصر، فنشر المجموعة في صيدا بلبنان، وعندما حاول الناشر إدخال الكتاب مصر صودر ومنع من التوزيع. وفي تقديمه للطبعة الثانية للكتاب، الصادرة في أبريل 1959، يضيف طه حسين إلى إهدائه القديم فقرة جديدة؛ ذات مضمون اجتماعي: “إلى الذين يجدون ما لا ينفقون، وإلى الذين لا يجدون ما ينفقون، يساق هذا الحديث”، ثم يشرح ظروف نشر المجموعة متفرقة، ونشرها مجموعة في كتاب: “في بعض ذلك العهد نُشِرت هذه الأحاديث متفرقة، فلم تحفل بها الحكومة القائمة إذ ذاك، ولم تلتفت إليها، ولكنها جُمِعت ذات يوم في كتاب، وأرادت أن تصل إلى أيدي القرَّاء مجتمعةً لتعظ المسرف، وتعزي المحروم، وهنالك حفلت بها تلك الحكومة والتفتت إليها، ووقفت عندها وقفة لم تطل، وإنما صدر فيها الأمر بأن يحال بين هذا الكتاب وبين الناس، وبأن تؤخذ نسخة من المطبعة إلى حيث يصنع بها السلطان ما يشاء، يحرقها أو يخرقها أو يغرقها أو ما شاء الله من ألوان العبث، ما دامت لا تصل إلى أيدي القراء! وكذلك صودر هذا الكتاب فيما صودر من كتب أخرى.. وإذا هو يسلك طريقه إلى لبنان فيُطبَع فيه ويُنشَر، ويُذاع في أقطار البلاد العربية، ثم يعود إلى مصر فيدخلها خائفًا يترقب، ويستخفي به قراؤه استخفاء، ثم يُعَاد طبعه ونشره في لبنان، والقراء من المصريين يسمعون بذلك فينكرون فيما بينهم وبين أنفسهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بهذا النكير.. تصادر كتابًا في مصر، وتظن أنها حالت بينه وبين المصريين، ثم لا تلبث أن تراه قد نُشِر في لبنان وعاد إلى مصر فقرأه الناس فيها”.
“المعذبون في الأرض” ليست مجموعة قصصية بالمفهوم الأدبي والنقدي، فهي تضم جانبًا من ملامح القصة والمقال الأدبي والمقال الصحفي، ويظهر ذلك بوضوح في الفصل الحادي عشر، المؤرخ في 10 أكتوبر 1947، والمعنون “مصر المريضة”، والذي ربما يكون أهم أسباب منع طبع وتوزيع الكتاب، في ذلك الفصل الذي هو آشبه بالمقال السياسي والنقد الاجتماعي، يري طه حسين أن مشكلة كبرى مثل وباء الكوليرا الذي أصاب مصر وقتها، هي مشكلة هينة، مقارنة بمشكلات أكبر، ربما كانت هي السبب في انتشار هذا الوباء وغيره، وهو إذ ينحي الكوليرا جانبًا يتحدث عن السعادة، والحرية، والأمن، والاستقلال، ويصف حال الحزن العام في مصر، ثم يضيف: وفيه الحزن بعد هذا وذاك لهذا البلد الذي صُرِفت عنه ضروب الخير في السياسة والثقافة والاقتصاد”، في المقال شعور عام بخيبة الأمل، ويختم طه حسين المقال بهذه الفقرة الدالة” “إن المصريين بين اثنتين لا ثالثة لهما: فإما أن يمضوا في حياتهم كما ألفوها، لا يحفلون إلا بأنفسهم ولذَّاتهم ومنافعهم، وإذن فَلْيثقوا بأنها الكارثة الساحقة الماحقة التي لا تُبقِي ولا تذر؛ وإما أن يستأنفوا حياةً جديدةً كالتي عرفوها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قوامها التضامن والتعاون وإلغاء المسافات والآماد بين الأقوياء والضعفاء، وبين الأغنياء والفقراء، وبين الأصحاء والمرضى، وإذن فهو التآزُر على الخطب حتى يزول، وعلى الكارثة حتى تنمحي، وعلى الغمرات حتى ينجلين. إلى أي الطريقين يريد المترفون من المصريين أن يذهبوا: إلى طريق الموت أم إلى طريق الحياة؟”.
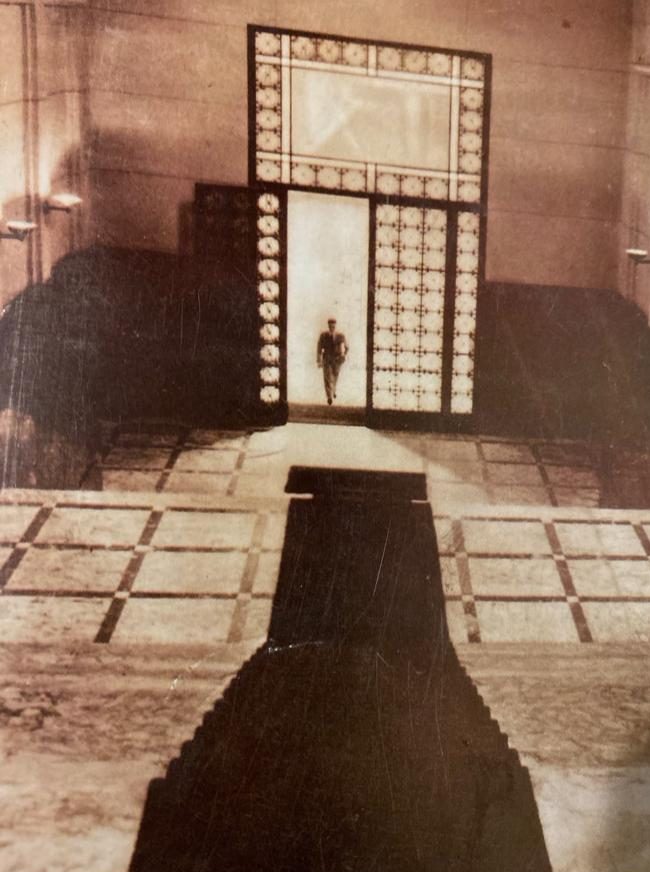
الأديب الشاب عباس العقاد في مدخل مبنى دار الهلال الجديد؛مجموعة دار الهلال في كتاب فوتوغرافيا مصر
٠٠مصر المريضة
جرى تعديلان على المراسيم الملكية بإنشاء جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول: التعديل الأول حمل توقيع اللواء محمد نجيب، القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ورئيس الجمهورية، فتغير اسم الجوائز إلى “جوائز الدولة للعلوم والآداب”، مع الحفاظ على الطبيعة العامة للجوائز، وقيمتها المادية، وإضافة العلوم الاجتماعية والفلسفة إلى الآداب والقانون والعلوم. لكن عمر اللواء في السلطة كان أقصر من أن يرى حفل توزيع الجوائز، ويمكن بسهولة ملاحظة أن الإضافة “الثورية” تتمثل في إدخال العلوم الاجتماعية والفلسفة إلى مجالات التقدير والتكريم الملكية: الآداب والقانون والعلوم. والتعديل الثاني صدر في عام 1958، حاملا توقيع، الرئيس جمال عبد الناصر، واستند إلى الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة وإلى ثلاثة قوانين: الأول أصدره اللواء نجيب، والثاني والثالث أصدرهما عبد الناصر سنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، والمجلس الأعلى للعلوم.
في تلك المراسيم (الدستورية) والقوانين هناك عدة مسائل متصلة بالسياق العام الذي شرعته البداية الملتبسة للجوائز، والمتعلقة بآراء عفيفي (باشا) وصدقي (باشا) في الديمقراطية والحياة الحزبية والبرلمان، فدستور الوحدة “المؤقت” ينص على أن: “يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضاء ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية”، وهو ما يذكر بالنقد الجذري العنيف الذي وجهه صاحب فكرة الجوائز للحياة الحزبية والبرلمانية، كما تذكر بنقد صدقي الأكثر جذرية، فهنا ليس فقط إلغاء لكل مظهر للديمقراطية والحياة الحزبية، بل خيالاً يتجاوز كل هذا إلى حد أن يختار “الرئيس” كامل السلطة التشريعية، التي لن تستطيع بعد اختياره لها أن تعقد جلسة لمجلسها (الأمة) دون دعوة منه.
صدر دستور الجمهورية العربية المتحدة “المؤقت”، في مارس 1958، الذي منح الرئيس حق اختيار أعضاء مجلس الأمة، وظل الرئيس يفكر من سيختاره لأكثر من عامين، وفي 21 من يوليو 1960 عقد مجلس الأمة أولي دوراته ولم يكمل العام وفضَّ، وبعد نحو شهرين وقع الانفصال. وفي مذكراته، يكشف، البغدادي، بدقة تامة جوانب من الصراع المحتدم بين “الضباط الأحرار”، فبصفته رئيسًا لأول مجلس نيابي في عهد الثورة، وإلى جانب كمال الدين حسين (كان عضوا في المجلس ووزيرا للتربية والتعليم في الوقت نفسه) كانا في صراع ظاهر مع سطوة وتحكم عبد الناصر، وإذا قدما استقالتهما من مجلس الأمة واجها رفض باقي الرفاق، ووصف حسين الشافعي الاستقالة بأنها “شرخ للثورة”، ووصفها زكريا محي الدين بأنها “هزة للنظام وإظهار أننا فشلنا في تحقيق هدف إقامة حياة نيابية سليمة”. وتشير واقعة الصراع تلك في الأيام الأخيرة من سنة 1957، والتي توجت الفصل الأول القصير للغاية للحياة النيابية في “ظل الثورة” إلى التشابه الكبير بين آراء حافظ عفيفي وإسماعيل صدقي حول الحزبية والحياة البرلمانية والديمقراطية وبين آراء ضباط يوليو؛ وبالأخص جمال عبد الناصر.
ويشيد قانون 1958 في مذكرته الإيضاحية بالميراث الملكي، لكن ليس برحابة صدر قانون اللواء نجيب (1953) الذي نصَّ صراحة على مسمى الجائزتين (فؤاد وفاروق)؛ وإن في معرض الحديث عن محوهما، لكن ديباجته كانت تعتبر أن تلك التقاليد الموضوعة في العهد الملكي لا تحتاج لكي تبقى صالحة في العهد الجمهوري سوى تغيير اللافتة فقط (المسمى)، وكان الأمر في بعض الأحيان يحتاج فقط لتغيير المواقيت، مثلما حدث مع عيد العلم، الذي شرع الاحتفال به الملك فاروق في 17 أغسطس 1944، ونقله جمال عبد الناصر عام 1955 ليكون في 21 ديسمبر، وكان التبرير أن ذلك أنسب لأنه اليوم الذي افتتحت فيه الجامعة الأولى (سميت أولاً حين افتتاحها عام 1908 “المصرية”، وعرفت بالجامعة الأهلية، ثم سميت فؤاد الأول 1940، وبعد الثورة أصبحت القاهرة 1953).
وقد عمل قانون 1958 على تقسيم الجوائز إلى مستويين: تقديرية وتشجيعية، كما راعى طبيعة المتغيرات الاقتصادية التي وقعت خلال أحد عشر عامًا فجعل قيمة الجائزة “التقديرية” إلى 2500 جنيه، و”التشجيعية” 500 جنيه. وهذه التراتبية “المالية” هائلة الفروق (خمسة أضعاف)، أولاً، ثم وقع الكلمتين، ثانيًا، بذرة أخرى ظهر فسادها مرات عدة، فمن يستحق التقدير ومن يجب تشجيعه، وما هي المعايير؟ هذه الأسئلة ترددت آلاف المرات، لكن أكثر الصور العبثية تعبيرًا عن تلك المعضلة جرت في القاعة الكبرى في جامعة القاهرة في 21 فبراير 1967؛ قبل أقل من أربعة أشهر على هزيمة يونيو، في ذلك اليوم كانت كل التقاليد الجمهورية/ الناصرية محتشدة، ضيف عربي (الرئيس العراقي عبد السلام عارف) وشباب وشابات يحملون الأعلام، وأطفال يقدمون الورود، ومغنية تغني “نشيد العلم”، والمجموعة تغني “ناصر”، والجمهور يردد وراءها، وصاحب التقديرية في الآداب، شاعر الشباب، أحمد رامي، ينشد قصيدة، وحين يأتي الدور على أصحاب التشجيعية ينادى على الخطاط محمد رضوان علي، ويصعد الرجل العجوز المريض بصعوبة إلى خشبة المسرح، متعكزا متعثرًا حتى كاد أن يسقط، وكاد طربوشه أن يسقط عن رأسه، والرجل الذي جاوز عامه الثالث بعد الثمانين، يتلقى شهادة وميدالية “التشجيع”، ولم تمض سوى أسابيع حتى وافاه الأجل، ثم ينادى: المرحوم أنور المعداوي، جائزة الدولة التشجيعية في الدراسة الأدبية، وكان المعداوي قد توفي قبل شهرين، بعد أن ترك القاهرة وصخبها، ليقيم في الريف، معتزلاً الحياة الثقافية، أما الكتاب الذي نال عنه “التشجيعية” فقد نشر في العراق بعدما صعب نشره في مصر.
العودة إلى صاحب “مصر المريضة” مرة أخرى له أهمية فائقة، فهناك تلك العلاقة الوثيقة الناشئة بين عميد الأدب العربي وبين كمال الدين حسين، وزير التربية والتعليم، ورئيس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، علاقة تعززت بقوة إبان أزمة مجلس الأمة والاستقالات في نهاية 1957، وهناك نشر “المعذبون في الأرض” في السلسلة التي يشرف عليها يوسف السباعي، أمين عام المجلس، وفي المقدمة يحكي “العميد” ظروف النشر في المرة الأولى، ولم يوفر جهدًا في هجاء العهد “البائد”، ثم ختم بتقريظ العهد الجديد “وها هو الفجر الصادق قد أخذ يشير إلى الظلمات المتراكبة المتراكمة بأصبعه الوردية التي ذكرها الشعراء، فتنهزم متفرقة كأنها لم تزدحم ولم يركب بعضها بعضًا، وما هي إلا أيام وأسابيع، وإذا الفجر الضئيل يمتد ويتسع، ويملأ الأرض نورًا وجمالاً وبرًّا وإنصافًا؛ وهنالك لا يحتاج الأديب إلى حيلة ليعرب عن ذات نفسه، ولا إلى رمز يخفي به سرَّ ضميره على الرقباء، وإنما يتحدث إلى قرائه في صراحة ووضوح، ويسر ورضى، يصوِّر لهم حياة ناعمة، وعيشًا رغدًا، وعدلاً واسعًا، بعد أن صوَّر لهم جحيم البؤس والجور والشقاء”، وحين بدأ يلقي كلمته باعتباره ممثلاً عن الفائزين بجوائز الدولة في ديسمبر 1958، كان الرابط الخفي يتصاعد تدريجيا من بين الكلمات، فهو إذ يشير إلى أحمد لطفي السيد، يستدعي بلا شك وقائع 1947، حين كان “أستاذ الجيل” رئيس اللجنة الدائمة لاختيار جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول، بل إن جرس كلمات “العميد” يبدو لوهلة وكأنها رجع صدى لكلمات الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري باشا، وهو يقول “يا مولاي.. وها نحن نمد النظر إلى آفاق بعيدة، آفاق يشع منها النور قويًّا وهاجًا، ونرى النور يقترب منا رويدًا رويدًا، ولكما اقترب زاد إشعاعًا وقوة، فهل يغمر مصر وهي تمشي إلى مستقبلها هذا النور المتألق؟ لقد أخذت غياهب الجهل تنقشع عن سمائنا، يبددها هذا النور الذي يقترب، فليكن سيرنا نحن النور، ولنمش إليه بخطوات ثابتة، فإن هذا النور الذي نراه هو مرآة الماضي، وعنوان الحاضر ورجاء المستقبل”. لكن كلمات السنهوري تلك لم يتردد صداها مرة أخرى، فحين أُعلن فوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1970، كان الزمن قد طوى العهدين، وكان الفقيه القانوني الكبير طريح الفراش، ولم يكن هناك مجال للتقاليد كي تتمظهر في سنة الأفول الناصري، وكانت “مصر المريضة” تنتقل إلى طور جديد من الحجب والمنع.
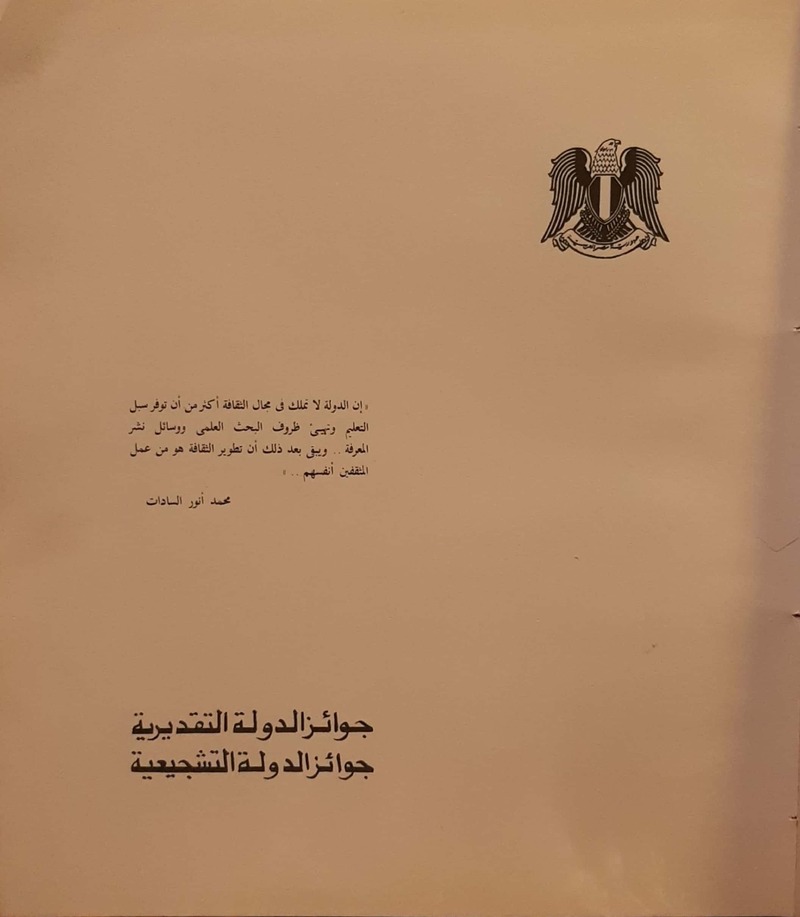
٠٠لا داعي للحرج!
اِصطَفَّ خلف الدكتور محمد حسين هيكل؛ عدد من أشباهه ممن التبس حصولهم على جائزة الدولة بشغلهم لمناصب كبرى في بنية الدولة المصرية خلال عصر حسني مبارك، والقائمة دالة على قصرها، تبدأ بالدكتور محمد صبحي عبد الحكيم (1928- 2009)، والذي قبل الجائزة (1984) وهو رئيس لمجلس الشورى (شغل الموقع بين أعوام 1980 و1985)، وقد جاء إلى منصبه هذا بعد أن تدرج في سلك التدريس الجامعي، رئيسًا لقسم الجغرافيا وعميدًا لكلية الآداب ونائبًا لرئيس جامعة القاهرة، وخلفه جاء الدكتور أحمد فتحي سرور الذي نال نفس الجائزة عام 1992 في سنته الأولى كرئيس لمجلس الشعب (ظل عشرين عامًا ولم يترك موقعه إلا بعد أن حل الرئيس حسني مبارك المجلس في محاولة منه لتلافي طوفان المعتصمين في ميدان التحرير في يناير 2011)، قادمًا من منصب وزير التربية والتعليم، الذي وصله بعد تدرج في سلك التدريس الجامعي في كلية الحقوق وجامعة القاهرة، وقد ترافق مع الدكتور سرور في تلك السنة (1992) رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي (الحائز على تشجيعية الدولة في الاقتصاد عام 1967)، ورئيس وزراء سابق، هو الدكتور علي لطفي، نال تقديرية العلوم الاجتماعية أيضًا الدكتور صوفي أبو طالب (عام 1990) الذي كان رئيسًا لمجلس الشعب (1979- 1984) ورئيسًا مؤقتا لمصر عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وقد جاء أيضًا من السلك الجامعي (رئيسًا لجامعة القاهرة)، أما الدكتور رفعت المحجوب، الذي اغتيل وهو رئيس لمجلس الشعب (1990)، فقد نال الجائزة قبل وصوله إلى رئاسة مجلس الشعب بأربع سنوات.
هذه القائمة القصيرة هي التعبير الأمثل عن مآل هذه الفقرة من ديباجة قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة، جمال عبد الناصر، سنة 1958، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب “إن المراد هو إشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له”، وهي تدلنا على الكيفية التي حلت بها الدولة المصرية معضلتها الحزبية والبرلمانية التي كانت تؤرقها منذ الخطوات الأولى، ومرت بكل محاولات الالتفاف حولها حتى جاءت الصيغة “المباركية” تلك. وقد حدث لغط كثير، بالطبع، عند الإعلان عن منح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية للدكتور عاطف والدكتور سرور، وسئل وزير الثقافة، فاروق حسني، مرات عدة: هل يجوز أن يفوز أكبر مسؤولَيْن في مصر بعد رئيس الجمهورية بأكبر جائزة مصرية؟ وكان رده عنوانًا عن عمق المرض “أعتبر هذه النتيجة التي وصل إليها المجلس الأعلى للثقافة في منتهى الشجاعة. ويكون الأمر في منتهى الخسّة والضعف لو فسَّرنا الفوز على ضوء المنصب السياسي الرفيع لكل من الفائزين. المجلس الأعلى للثقافة لا يتلقى أوامره من أحد ولم تُفرض عليه أسماء معينة. كما أن المجلس الأعلى للثقافة لا يرشح الفائزين إنما تقوم بذلك الهيئات العلمية. وفي هذه الحال لا يملك المرشح أن يعتذر، ولا يملك المجلس الأعلى للثقافة أن يرفض الترشيح، بل يصوت أعضاؤه سلبًا أو إيجابًا. وهذه مخاطرة يدخلها المرشح، وخصوصًا الرجل السياسي؛ أن يقف تحت رحمة وحكم رجال الثقافة، وهذه جرأة من السياسيين وجرأة من المجلس رغم أقاويل الكثيرين.. أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في مصر أناس بلغوا من الرقي والحكمة والوقار مكانة تجعلهم غير محتاجين لشيء، ومن ثَم فإن المعايير التي اعتمدوها في الاختيار تأتي مجردة من كل شبهة”.
في (1947)؛ الذي جري فيه “الحجب”، أو “التأجيل” الأول، كان الاسم الوحيد المتوقع؛ بالإضافة طبعًا لطه حسين، هو علي مصطفى مشرفة عالم الفيزياء النظرية الشهير، لكنه لم ينل الجائزة حتى وفاته، التي اثيرت اقاويل كثيرة حولها، ولا حاجة للاستغراق في تتبعها هنا، على أهميتها، فما له علاقة بسياقنا هو تواتر الحديث عن عداء الملك فاروق له، ما يلقي بظله على حقيقة تجاوز الجائزة في عامها الأول لشخصية علمية هامة للغاية كانت تستحقها عن جدارة. وقد التبس الأمر على كثيرين فخلطوا بين (علي) العالم الشهير وبين شقيقه مصطفى مصطفى مشرفة الأديب، الذي كتب رواية شهيرة هي”قنطرة الذي كفر”؛ لها خصوصية بالغة، فيعدها بعض النقاد عملاً رائدًا، باعتبارها أول رواية كتبت كاملة بالعامية المصرية ولأنها من أوائل الروايات العربية التي استخدمت ما سمي في النقد الحديث “تيار الوعي”، ولأنها تتناول دراما الحياة الشعبية إبان ثورة 1919 وما واكبها من حركة جماهيرية انطلقت بالفطرة لتحمي زعيمها سعد زغلول ومبادئه التي نُفِي من أجلها.
وبعد نصف القرن بالتمام من واقعة الحجب الأولى لجائزة فؤاد الأول للآداب، أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بإنشاء جائزة باسم جائزة مبارك، ما يستدعي مباشرة كل الكلمات التي سيقت في قرارات “قائد ثورة الجيش اللواء محمد نجيب”، كأسباب لتغيير تسمية جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول، خاصة هذه الكلمات”: ونظرًا لإلغاء النظام الملكي وسقوط حكم أسرة محمد علي رأت وزارة المعارف أن تغير اسم هذه الجوائز إلى جوائز الدولة للعلوم والآداب”، وحين اعتبرت تسمية جائزة باسم مبارك “ردة عن للتقاليد الملكية والأسر الحاكمة لا تليق بالنظم الجمهورية، كانت كلمات الوزير حاضرة في رجع بعيد “التعليقات سلبية لأن أصحابها فكروا دون حياء وبشكل منحاز، وربما حركت البعض أغراض وأغراض”.
لقد تميز عهد مبارك بين العهود “الجمهورية” بنوع من “الاستقرار” على صعيد السياسات الثقافية، فقد ضرب فاروق حسني رقمًا قياسيًّا في البقاء وزيرا للثقافة (1987- 2011)، ومن ثَم فرض ذلك الاستمرار “طابعًا” من الهدوء النسبي الروتيني، فكان عمر الأزمات قصيرًا للغاية، وانتهت في أغلبها دون خسائر تذكر للسلطة، الاختراق “الرمزي” في ذلك البناء كان موقف صنع الله إبراهيم وإعلان رفضه لجائزة القاهرة للإبداع الروائي العربي (2003)، وتسمية جائزة الدولة الكبرى باسم مبارك، الواقعتان على تعارضهما، الظاهري، تبدوان متساندتين، ظهر صنع الله وحيدًا تمامًا، كالطفل في القصة، يصيح بعري الملك، وكان قرار تسمية الجائزة باسم مبارك إقرارًا قاطعًا من الدولة المصرية بنهاية “الريادة والفرادة” التي وسمت التاريخ المصري المعاصر في علاقته بمحيطه الثقافي العربي، فقد ظلت لنحو عقد تلهث دون جدوى رافعة القيمة المادية لجوائزها لتلحق بالأرقام الكبيرة التي كانت تمنحها جوائز سميت بأسماء سلاطين وملوك وأمراء وشيوخ ورؤساء وزعماء عرب، كانت تلك الجوائز بقيمتها المالية المرتفعة جدًا مقارنة بقيم جوائز الدولة المصرية لا تشير فقط إلى اختلال التوازن بين مصر ومحيطها “ماديًّا”، بل أيضًا معنويًّا، فقد تكرر مرات عديدة أن يطلب مثقفون مصريون ألا يرشحوا لجوائز الدولة لأنهم مرشحون لجائزة عربية قيمتها المادية أضعاف مضاعفة قيمة الجائزة “الوطنية”، وعند تذكيرهم بالمعنى الأدبي لتكريم الدولة المصرية لهم كان الحديث ينزلق إلى دروب مفجعة.
كان تسمية الجائزة الكبرى باسم مبارك إعلان هزيمة رمزي للدولة المصرية وريادتها الثقافية في المنطقة. وكان الصراع رغم ذلك يزداد احتدامًا على قيمة الجوائز المادية، فالفائزون في السباق العربي قليلون، والمتبارون كثر، والحل تعلية البناء الهرمي التراتبي، وهكذا أصبح هناك أربعة مستويات: مبارك، التفوق، التقديرية، التشجيعية. وإذ تعود البلاد إلى الإعلانات الدستورية يصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، قانونًا “يُستبدل بموجبه مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك”.
هناك خيط ممتد لأبعد قليلاً من محاضرات الجمعية الجغرافية الملكية، والتي نظمها الاتحاد المصري الإنجليزي، وتحدث فيها حافظ عفيفي “باشا” عن الحياة البرلمانية وأعلن موقفه الجذري من نقد الديموقراطية والحياة الحزبية والبرلمانية ومجمل الحياة الدستورية الحديثة، قد تكون بداية هذا الخيط من سجلات الجمعية نفسها وظروف تأسيسها، وشخصيات من ترأس إدارتها في سنواتها الأولى، ففي سجل الرؤساء سنجد أسماء أمراء وخديو وملك وباشاوات. إذ دارت الجمعية إذا من “الخديوية” إلى “الملكية”، حتى وصلت إلى “الجمهورية”، حيث فقدت رونقها “الاجتماعي” الذي طبع عهديها السابقين، لكنها ظلت فخورة بحكم التاريخ العلمي “كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين”. وهذا الخط يصل بنا إلى الرئيس الحالي الأستاذ الدكتور السيد السيد الحسيني، الذي برز اسمه خارج النطاق “العلمي” في ذروة تصاعد أزمة “تيران وصنافير”، فطوال الفترة من 8 أبريل 2016، تاريخ توقيع الحكومتين المصرية والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينهما، والتي أقرت بتبعية الجزيرتين للسعودية، وحتى 17 أغسطس 2017، تاريخ نشر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقرار مجلس النواب للاتفاقية، كان الحسيني الصوت “العلمي” الأعلى في الدفاع عن تبعية الجزيرتين للسعودية، وليس فقط للدفاع عن صحة إقرار السلطة بذلك، وقد حمل دفاعه ذاك على عدة اعتبارات، فهو، أولاً، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وثانيًا، أستاذ متفرغ بقسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة القاهرة، وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، ومشرف عام على معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي؛ وهو معهد مهمته الرئيسية “تلقين” نخبة من الطلاب الجامعيين خطاب الدولة (الرسمي)، ليس مهمًا بالطبع البحث في القيمة العلمية لكون الدكتور الحسيني عمل لسبع سنوات متصلة في عدد من الجامعات السعودية، ويصعب بالطبع البحث حاليًا عن الرابط بين تسمية الدكتور الحسيني في عام 2015 رئيسًا للجمعية الجغرافية المصرية، وبين موقفه من الجزيرتين بعد أقل من عام من ترأسه للجمعية، رغم وجود بالطبع من هو أقدم منه “علميًّا”، كما يصعب البحث عن الرابط بين موقفه وبين تسميته مقررًا للجنة الجغرافيا في المجلس الأعلى للثقافة بعد أيام فقط من توقيع السيسي، رغم وجود من هو أقدم منه أيضًا، فذلك الأقدم كان له نفس الموقف المؤيد لقرار السلطة.
كانت هذه بعض الوقائع الغفل عن جوائز الدولة منذ كانت فكرة حتى عامنا هذا، وهي تحتاج لمزيد من البحث والفحص قبل الشروع في البحث عن معانٍ ودلالات، لكن يمكن المجازفة بالتفكير في أن الجوائز نبتت كفكرة وكمسعى وتحركت بين الأروقة البيروقراطية بقصد تخليد الملك المتوفى والملك الشاب، وكي تمنح الدولة رجالها المخلصين بعض التكريم وبعض الأموال، وإذا كانت الأسماء التي دفعت بالفكرة إلى حيز الوجود قد عبرت عن أفكارها بدقة ومباشرة صارخة باعتبارها معادية للديموقراطية والحياة الحزبية والبرلمانية، فكان من الطبيعي والمنطقي أن ذروة تألق حضورها وتمظهرها في تقاليد حدثت في السنوات التي ألصق بتلك الأفكار والممارسات أشنع الأوصاف، فمشاهد تكريم الحائزين على تقدير وتشجيع الدولة أشبه بكرنفال احتفالي باذخ، وكان الاحتفال الذي سبق هزيمة يونيو 1967 أكثرها تعبيرًا عن عمق أزمة جوائز الدولة بينما مصر تدخل في طور جديد من المرض، أما غياب الكرنفال تمامًا في عصر مبارك فيرجع؛ ليس فقط إلى كراهيته للأفكار والإبداع والفن، بل لأنه جاء إلى قمة السلطة عبر حادث في الاحتفال الأعظم للدولة المصرية قتل فيه رأس الدولة.