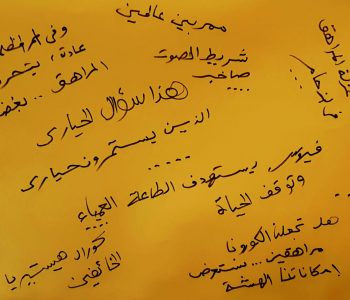“كانت النساء يهربن بالكعب العالي من الحفل..”
سمعت الحكاية بتلذذ على التليفون بعد ساعات قليلة من وصولي إلى الجونة.. رأيت فيها فانتازيا؛ تترنحُ فيها صاحبات الكعب العالي أمام هجوم فرقة وزارة الصحة “سُلطة الأمر الواقع”. فانتازيا تضخم الدقائق القليلة التي أنهت الحفل، خصوصًا والسلطة التي تراقب المسموح والممنوع جديدة على خبراتنا السابقة بالفرق البوليسية هادمة الملذات.
الحياة الليلية أهم ملذات مهرجان الجونة، منحت المهرجان طبيعته الحرة المثيرة للفضول والنميمة، وطبعًا السباق الخفي للحصول على تذكرة للدخول إلى العالم الخيالي للحفلة /البارتي وما بعد البارتي/ الحفلة After party.
…
لاحِظ أن الحفلة جزء من كل مهرجان، لكن في الجونة، ونظرًا إلى طبيعة وجود المنظمين والضيوف والجمهور خلف أسوار واحدة، ومحبة مؤسسيها للحفلات، فإن الجانب الكرنفالي يبتلع مساحات أكبر من حجمه وأكثر انتشارًا من الكلام عن الأفلام نفسها.. أنت في الجونة تسكن مع/ أو على بُعد خطوات من النجوم؛ من الممثلين وأصحاب الثروات الخرافية.. وبتذكرة واحدة ستعيش عالمهم المشبع؛حسب خيالك؛ بالغرابة والفانتازيا المفرطة.. لن تكون مجرد متفرج أو مستمع.. وهذا يفقد ضيف المهرجان؛ من خارج العالم المغلق للنجوم والأثرياء، طبيعته المحايدة، فيقف معلقًا بين كونه جزءًا من هذا العالم أو مطرودًا منه. (الجونة المهرجان الوحيد تقريبًا الذي ينظر إلى كل المدعوين فيه نظرة واحدة.. صحيح بدرجات يختلف فيها النجم عن الصحفي عن القادم من عالم الثروات.. والموظف في فرق إدارة المهرجان.. لكنهم جميعًا يخضعون لنظرة عمومية ويصيبهم طيف من مشاعر توجه للمشاركين في الطقوس؛ تبدأ بالمداعبات الظريفة الخفيفة.. ولا تتوقف عند الهجوم).. وهذه حالة غريبة تنتقل إلى وعي المستوى الأعلى من الإدارة، حتى إن المدير الفني وصف الهجوم على تكريم جيرار دي بارديو بأنه “مُوجَّه من المحرومين من دعوات المهرجان”.. نعم، بمجرد دعوتك أصبحت متحدًا مع المهرجان.. وهذه من العجائب التي تجعل النظرة من خارج الأسوار كما لو كان الجميع هنا يسيرون على مسرح كبير.. الناس تتفرج عليك سواء كنت على السجادة الحمراء أو نائمًا على سرير في غرفتك بالفندق.
هل أنت حر عندما تصلك مشاهد فانتازية مثل المترنحات بالكعب العالي؟ هل ستنحاز إليهم باعتبارهم طالبات فرصة حرية في مجتمع محافظ متلصص.. أم ستكون مع وصاية فرقة الصحة.. أم ستنضم إلى صائدي الفضائح؟
ضحكتُ كثيرًا، وأنا أختارُ الموقع الذي سأحكي منه القصة.. وأخفيتُ عن زملاء جلستي في ممشى المارينا سبب الضحكة.. غالبًا لأنني تخيلتُ كيف ستلمع أعين الضباع..
هناك خيط رفيع تظل فيه الفانتازيا مبهجة.. بعدها تتحول إلى جثة ينتظرها الضباع..
…
آه الضباع يعيشون على جثة كل شيء؛ الفن والحياة والحرية.. ويسيرون بيننا كأنهم مفتشون وحكماء..
…
خفتُ من الفانتازيا فجأة، وداريتها بالكامل حتى عن الناس العاديين.. وليس عن الضباع فقط، كما أخفيتُ رغبتي في حضور المشهد، ومشاهدة فرق الصحة وهي تمثل الدولة بقوة الكورونا.. سلطة تتجسد في فرق كاملة بقيادة موظف كبير.. وأكشاك زرقاء.. وأكياس كرتون عليها صورة الرئيس السيسي، تحتوي هدايا مقاومة الكورونا؛ كوب ماء وزجاجة كحول وغطاء للرأس كلها تحمل صورة الرئيس.. إلا الكمامة والمنشفة الصغيرة.. الكيس يصلك أينما كنت؛ في الغرفة والشارع.. في مقر المهرجان.. في (الجامعة الألمانية).. في دور السينما.. تدخل دون استئذان قبل وصولك إلى السرير.. وتخاف أن تنساها على طاولتك.. في الحقيبة فرقة الدولة لمكافحة الوباء.. تتكاثر الأكياس في لحظات حتى تدخل مجال الدهشة والذكريات والسخرية أحيانًا.. فهي تمثل الحضور الرمزي لسلطة غير مرئية.. لحمايتنا من وباء غير مرئي هو الآخر..
تخيَّل تلك الحرب التي لا نراها بين الفيروس والسلطة.. تخيَّل أبطالها وكيف يرون الهائمين على وجوههم في الجونة.. وكيف أنها حرب ضحاياها من غير المتحاربين.. ضحايا دوائر من المصابين بالكورونا عادوا إلى غرف العزلة الشخصية.. وكأنها دخلوا دائرة في الجحيم.. من العزلة إلى المهرجان والعكس.. إنه فيلم من الرعب المعاصر.. لا يستدعي أساطير وكائنات من عالم تحتي.. الرعب يعيش حولنا ولا نراه.. قد يمتصنا بلمسة.. مجرد لمسة.
تخيَّل أيضًا مشهد الهاربات المترنحات بالكعوب العالية؛ مشهد سينمائي، مثقل بكل قدرات السينما على تكثيف الزمن في مشاهد مشبعة.. آه.. دربت السينما عقولنا على اللعب مع الأفكار والعواطف بهذه الطريقة المفعمة في رسم المشاهد، البذرة كانت في أدوات العقل لكن السينما طوَّرتها إلى درجة تكوين فيلم سينمائي كامل في شاشة داخل العقل.. الواقع يصلنا أحيانًا على شكل فيلم.. وكل حسب مزاجه وذوقه في السينما..
هذا هو الفرق بين النميمة المجردة والسينما.. تتلصص السينما كي تمنح مشاهدها قوة من مكان آخر غير متعة تقطيع السير، المكان الآخر حياة نعيشها دون الخضوع لسريان الزمن على مزاجه.
السينما تكسر فكرة الزمن المطلق الذي يسير دائما إلى الأمام.. وتمنح القادر على صناعتها توقيف الزمن وتحويله إلى فتافيت.. تبني عالمًا خارج سيطرة الواقع الصلب.
…
هذه هي السينما التي أحبها.. توجد سينما أخرى تحاول إعادة تمثيل الواقع بكل ابتذاله الثقيل اللزج.. وسينما تصنع تفاهة محببة.. وسينما تمارس لعبة التطهير بتصاعد ميلودرامي تجاه النهاية السعيدة.. وسينما تلتصق بالواقع وتلغي المسافات لتتحول إلى برامج شكاوى تليفزيونية..
السينما التي أحبها تتبع صوتًا آخر من خارج المشهد يحوله إلى فن.. ولهذا يمكن أن ترى كل تفصيل في المهرجان من هذه الزاوية.. كيف تراها قطعة فنية لا تتكرر؟
…
فساتين وأقنعة.. فساتين وأقنعة.. فساتين.. و.. أقنعة.. ف…
…

فساتين من موديلات ممتدة من العصر الفيكتوري وحتى عصر الجواري الحديثة.. ومعها كمامة، وقناع طبي.. صورٌ ستكون تاريخية بعد عدة سنوات..
الأقنعة الطبية كانت مضحكة أحيانًا.. ومرعبة أحيانًا.. خصوصًا تلك التي تصنعها ماكينات الدعاية وتصوَّر فيها الشفاه على سطح الكمامة .. كيف نتحمل أعضاءً في الجسد طائرة وحدها.. أو بطبقتين إحداهما صورة؟ المشهد حربي ساخر.. كما لو كان هناك هاربين إلى معسكرات الفخامة.. يبحثون عن سبب لسيطرة غريزة الاستعراض على كل الغرائز..
وكي تتعمق فكرة الهروب سادت أفلام المآسي المعاصرة في هذه الدورة.. هجرة ومذابح ولاجئين وحروب شخصية للهروب من مصير السقوط في حفر التاريخ.. أو كما قالت المخرجة آنا روشا دي سوسا ما معناه أن “المهاجرين هم محاربو هذا العصر“..
هل قالت ذلك أو أن خيالي جعلها تقول هذه الكلمات لأتحمل 74 دقيقة، هي طول فيلمها “اسمع listen” الذي تورطنا فيه من الدقيقة الأولى مع مأساة عائلة برتغالية مع تغيير قوانين الطفولة والهجرة في إنجلترا سنة 2014.. ومن بين بيت في ضواحي لندن إلى المحكمة نعيش حربًا قانونية مع الموظفين الذين تحولوا إلى آلات لنظام بيروقراطي بلا رحمة.. المخرجة تشبعت بميلودراما قصة بطلتها، واعتمدت على قوة الممثلة لوسيا مونيز، لتلتصق بالقضية وكأنها فيديو لايف طويل على يوتيوب، لا يطلب سوى التعاطف وكراهية القانون وكهنته.. وهي مهمة قد تجلب الدموع، لكنها تفتقد للمتعة التي تخلقها مسافات غائمة، غامضة تجعل من القصة سينما…
غالبًا كنت أتخيل أن المخرجة قالت ذلك الكلام..
كنت أحاول تفادي الإعجاب المسبق بالفيلم.. وهي واحدة من عيوب فرجة المهرجانات.. هناك رأي عام.. وتمرد عليه.. وبينهما يغيب الذوق الفردي..
كنت أريد مشاهدة قصة من يحملون في الوصفات الرسمية لافتة: “مهاجر غير شرعي.. بلا أوراق”.. واسمه أنا “محارب من أجل الحياة” لكن الميلودراما هزمت المخرجة وأبقتنا جميعًا في دائرة التعاطف المحض مع امرأة تواجه القانون وحراس البيروقراطية لإنقاذ عائلتها..
شاهدت الفيلم البرتغالي/البريطاني بعد مشاهدة فيلم “تحت نجوم باريس” الذي تخلص من ابتذال التعاطف بالحس التوثيقي.. وبدا المخرج كلاوس دريسكيل الألماني في رحلة اكتشاف ثانية لطبقات باريس، المدينة الميجابول، الرحلة الأولى كانت في فيلم سابق اسمه “على حافة العالم” يترك المساحة كلها لأربعة من متشردي باريس ليرون حياتهم في العالم الخشن القاسي.. تعري الروايات الأربعة رومانسية باريس، كما قدمتها أغنية تحمل اسمًا قريبًا لاسم الفيلم.. الأغنية اسمها “تحت سماء باريس” وغنتها إديت بياف، وإيف مونتان؛ وتجعل من باريس أيقونة عاطفية لمحبي المدن الكبيرة، عابرة الزمان..
يصحبنا “تحت نجوم باريس” في رحلة أخرى تحت طبقات الجسر نفسه الذي تتغزل الأغنية في جماله.. وتكشف معنا طبقات عالم في الأدوار السفلية لباريس (كأنها أليس في الرحلة لكن دون العجائب).. تبدأ الرحلة بمتشردة باريسية قادمة من العالم المخملي لباريس (اللي فوق)، باحثة مرموقة، وسيدة فقدت أمانها الاجتماعي، ولا نعرف لماذا وصلت إلى مصير النوم في الشوارع، تقوم بالدور ممثلة وكاتبة باريسية، لعبت بخفة بين البائسة المرفهة.. والخائفة المكتشفة لخبايا عالم المطرودين من رحمة باريس.. وفي لحظة تورطها مع طفل من بوركينا فاسو تاه من أمه، تتطور مشاعرها من التبرم ومحاولة التخلص منه، حتى التورط الكامل في رحلة البحث عن الأم.. ولن أنسى مشهد محاولاتها في الهرب بالطفل عبر الطبقات السفلى من مترو باريس، ليحاصرها المتوحشون من قدامى سكان هذا العالم الباحثين عن وليمة.. وكأننا أمام مشروع التهام بشري؛ يشبه محاولات المسنين التهام الشاب ألكسندر بعد خروجه من معسكر التأهيل في فيلم “البرتقالة الآلية” لستانلي كوبريك..
الرحلة انتهت نهاية سعيدة؛ انتهت بالعثور على الأم.. لكن المخرج أفلت من فخ التطهر والميلودراما بهذا التوثيق لباريس التي لا نراها في الكارت بوستال وجولات السياحة.. كأن رحلة الطفل المهاجر خلفية لرحلة أخرى.. مفعمة بمشاهد تعبيرية لبطن باريس (بتعبير مستعار من رواية إميل زولا) المليء بالتوحش والبؤس والوحدة الرهيبة.
..
كأن السينما يمكنها أن تشير إلى تعدد طبقات،وليس مجرد سطح نسير عليه بكل ما نملكه من تباهٍ ساذج..
…
كأن السينما ليست مجرد وسيلة تسلية أو معرفة أو متعة لإشباع الحواس.. أو غسالة أفكار.. لكنها لعبتنا مع الحياة إذا كنا نحتفظ لا نزال بخفة اللعب..
لعبة تحركنا من مواقعنا الثابتة لنوجد في سحابة كبيرة من الاحتمالات..
كل يوم وجودنا فيه نقطة في السحابة..
نقطة.. مجرد نقطة..
…
لم أجد مقعدًا في فيلم “الماتادور المذعور” (ترجمة المهرجان)..أو “الماتادور الرقيق” (ترجمات مقترحة)، والمصادفة الغريبة أن المشهد الافتتاحي للفيلم يشبه مشهد الهاربات بالكعب العالي؛ إذ تهاجم قوات بوليس تابع لنظام ديكتاتور تشيلي الشهير بينوشيه حفلة للدراج كوين drag queen، وتطارد الفنانين والجمهور في شوارع المدينة..
لن تجد بسهولة ترجمة للدراج كوين، وهو اسم قديم يصف فنون تعبيرية تقدم نساء بباروكات ضخمة وزينة مبالغ فيها وملابس مثيرة.. وعادة يلعب هذه الأدوار رجال محترفون أو مثليُّون أو نساء.. لعبة من ألعاب الهوية الجنسية، يمكن قلبها أحيانًا بملابس وهيئة رجال، وتسمى drag king..
وهي غالبًا مساحة تكسر ثنائية الأنوثة والذكورة الكلاسيكية، وتقدم مساحة تعبير ساخرة واستعراضية للهويات المتصلبة.. وتفتح مساحة للتعدد الذي يواجه قمعًا مهولاً مصدره الرعب.. وتبدو استعراضات الدراج كوين هنا وكأنها إزاحة، أو نقل، أو جر كتل معابد قديمة إلى خارج مكانها…
كيف تعيش دون اسم في موقع تزيل فيه الحدود بين الذكورة والأنوثة؟
كيف “تلخبط” العالم وأنت بكل رقة “الكوين” كما لعبها ألفريدو كاسترو؟