قبل أن أعبر البوابة الكبيرة التي تفصلنا عن سجن القناطر للنساء، سألت نفسي: لماذا جئت إلى هنا؟!
تذكرت هذه اللحظة مع الموجة الأخيرة لقصص “قتل الأزواج”؛ وهذا هو التعبير الذي تختصر به الصحافة التقليدية جرائم تقتل فيها النساء رجالاً، وبين القاتلة والمقتول عقد زواج رسمي. هذا النوع من الجرائم يثير الشهية والرعب. وصدمته تهدد الاستقرار المبني على احتكار الرجل للسلطة والعنف، والمرأة لموقع الضحية وانتظار منح التعاطف والمعاملة الحسنة. وأغلب الظن أن الصدمة تأتي من تحكم الرواية التي تسود بها “الذكورية” والنظام الأبوي إلى درجة تضعها في مرتبة الأقدار الإلهية، والخروج عنها يهز عرش الكون. القتل طبعًا ليس مجرد خروج عادي، بل تهديد خطير، لا بد من السيطرة عليه بتضخيمه، أو بالسخرية من “انقلاب العالم” الذي يجعل الأزواج المساكين ضحايا للمرأة المتوحشة المتمردة على “قانون الطبيعة”. العنوان يغلب الرغبة في المعرفة والإدراك، لنفهم من انتشار “قتل الأزواج” أنها قصة واحدة تتكرر، عن توحش المرأة واستكانة الرجل. على الرغم أن كل منها قصة تقول لنا شيئًا كبيرًا عن العلاقات بين الرجال والنساء، وطبيعة “مؤسسة الزواج” والتناقضات الفائرة داخل العقل والجسم البشري، وركود الحدود والضوابط التي يضعها المجتمع من أجل استقراره، وتقول أيضًا إن القاتل/المجرم الذي يظهر فجأة ليس مفاجئًا، بل هو بخار مكتوم يتشكل عبر سنوات الضغط والقهر والكسل عن التفكير في النظرة والقيم والأخلاق الحاكمة للعلاقات بين البشر في المجتمع. المجتمع المحافظ ينسى دائمًا الديناميكية بين الثابت والمتغير، والقديم والجديد. ويرى في كل تغير أو تقدم أو مستجد خطر يبشر بالهاوية والضياع. المجتمع المحافظ مثل الديناصورات يفقد القدرة على الرؤية والتفكير والتحليل، مكتفيًا برفع رايات الخوف والتمسك بالثوابت، مع كل ظاهرة جديدة نسمع صيحة الديناصور قبل انقراض يحدث تدريجيًّا. تتحلل المجتمعات العاجزة عن التفكير في أننا كائنات قديمة نعيش كل يوم تغيرات رهيبة. وتدمن هذه المجتمعات الحياة وسط تعفنها بدلاً من الثورة والتمرد من أجل إنسانية أرقى وأكثر حرية وفهمًا.
كان من الطبيعي أن يشعر المجتمع بالرعب عندما قتلت سميحة عبد الحميد زوجها ووزعت جثته على أكياس بلاستيكية، لتكون أول قاتلة تتجاوز القتل إلى الإخفاء في البلاستيك. لكن المجتمع نفسه لم يسأل: لماذا قالت سميحة للصحف إنها لم تشعر بالندم؟ لم تثر قصتها الاهتمام بفهم طبيعة المجرم الكامن في أعماق رومانسية حالمة. وهذا ما حاولت فهمه عندما زرت سجن القناطر، وكانت سميحة نجمة عنبر “القتالات” (كما يطلقون عليه). رغم أن حكم الإعدام نفذ فيها قبل ربع قرن من زيارتي.

سميحة عبد الحميد تدخل غرفة الإعدام
حكاية الزيارة
في أحد أيام أغسطس عام 2004 خطفتني فكرة زيارة سجن النساء؛ وتحديدًا من أجل اللقاء مع القاتلات. نوسة أول سجينة رأيتها في القناطر، لم أعرف أنها مسجونة الا بعد فترة، كانت تتحرك بخفة ونشاط، وتضع على رأسها طاقية رياضية تحمي من الشمس.. أي أنها من المنتمين إلى الخارج، هي المشرفة على البوفيه، وقد طلب المأمور منها أن تجهز لنا نزيلات للحوار. بدأت في التفاوض مع “أبلة ميرفت” المشرفة الاجتماعية، التي أخذت تستعرض الأسماء واحدة تلو الأخرى “ناهد.. هناء.. سميرة”، وفجأة توقفت ونظرت إلينا “ما تعملوا مع نوسة”، عرفنا أن نوسة واحدة من أقدم نزيلات عنبر القتالات، وتعتبر مفتاح الخريطة السرية للسجينات. كانت تتحرك عبر الباب الموصل إلى ساحة العنابر حين سمعت اقتراح المشرفة وردت من مكانها “بلاش أنا والنبي.. آخر مرة عم الولاد منعهم من زيارتي.. وأنا قربت أخرج”.. حركتها لم تتوقف، وكانت وقتها تساعد إحدى السجينات على الوصول إلى ابنها الذي جاء للزيارة، وكانت تريد أن تلمسه بعيدًا عن القضبان. نوسة كانت خفيفة في الحركة وسط وجوه تصلبت على الأسلاك الشائكة، تنظر من بعيد على صالة الزيارة والأكياس المتخمة بالبضائع، ورجال ونساء وأطفال في صالة تشبه صالات جمارك بورسعيد، أو مكاتب الموظفين في الشهر العقاري حيث كل فرد يحتاج نفس الشيء في نفس اللحظة وبسرعة أكبر مما يحتمل المكان. كل زائر يعبر البوابة الكبيرة بعد أن يضع الحارس الخبير الختم على إحدى يديه، ودون هذا الختم يمنع الزائر من العودة العكسية من نفس البوابة التي لا يفتح فيها سوى باب صغير لمرور الضباط والحراس والأطباء والزوار في موعد الزيارة.
كنت أحاول تأمل الوجوه. هل تستطيع أن تعرف وظيفة كل شخص دون النظر إلى ملابسه؟ الملامح المتوترة التي استقرت في صفقة صمت هادئة تسيطر على المكان. ولا يبقى غالبًا في النظرة البعيدة للوجوه إلا لون الملابس؛ الكاكي للمأمور والعساكر، لون السلطة في محافظة القليوبية التي يتبعها السجن. والأبيض للسجينات، والأطباء وللممرضات، ولبعض الضباط في مهام خاصة من شرطة العاصمة. يبقى اللون الرمادي المحايد للحارسات والمشرفات الاجتماعيات. فقدت التوازن في اللحظة الأولى؛ لم أتحمل فكرة الغريب الذي يتفرج على عالم السجن. نحن الآن في الممر بين الخارج والداخل.. الحرية والقيود.. في مساحة مربعة تحشر مكاتب الإدارة، وعلى يمينها ساحة الزيارة، هذا قبل السلك الشائك الذي يحيط بالعنابر. هذه المساحة تشبه الممر لأنها تنعش كل المشاعر المثيرة بين عالمين. لست في الداخل.. ولست في الخارج “بين البينين”.. مغلق عليك باب تحتاج إلى أمر من صاحب السلطة على المكان لكي تخرج منه.. تعرف أنك ستخرج، لكنك تشعر للحظات بأنك تعيش حالة السجن. لم أكن خبيرًا مثل المحررين المحترفين في صحافة الحوادث/ الجريمة. ولهذا لم أنطق بكلمة واحدة لمدة ربع ساعة. كان خطاب مصلحة السجون يضعنا في مهمة محددة “نرجو السماح بإجراء حوارات مع المحكومات عليهن…”، وفى نهاية الخطاب “لكي يبرهنوا على أن الجريمة لا تفيد”. ضحكنا جميعًا من الديباجة الفخمة. المأمور والضباط وأطباء السجن مهتمون بحركة التنقلات في الشرطة. يصنع الانتظار توترًا مكتومًا، ترفع درجته الرغبات الملقاة في ممر الزيارة.. ثلاث فتيات يلوحن بإشارات جريئة وحركات جنسية، وعلى الباب نظرة استعطاف لسجينة تريد الذهاب إلى العيادة، وعلى اليسار تجمعات من النزيلات في ساعة الفسحة. تبدو الألوان الفاقعة وسط سيطرة الأبيض كأنها احتفالات مسروقة من النظام الحديدي.. هرولت سجينة عندما لمحت الضابط يصحبنا إلى المكتبة، وفي أثناء هروبها، وعبر السور بيننا وبينها، كان يمكن أن نلمح جسدها يهتز وعليه بلوزة بحمالات ملونة، بدت مثل رغبة فائرة في صحراء قاحلة. الجسد في السجن هو العلامة المتاحة لإحساس السجينة بأنها فرد وليست ضمن قطيع. ليس الموضوع هنا هو الأنوثة، أو الرغبات المكبوتة تحت لون البياض العمومي، بل الإحساس بالوجود الشخصي. لمحت في حجرة تعليم الخياطة سجينة تخرج من كيسها عبوة كريم لتدليك اليدين وتجرى حوارًا حوله.. وسجينة أخرى بدا لون طلاء أظافرها مميزًا؛ أخضر ومن النوع الرخيص. تابعت ألوان المكياج التي تحاول كل واحدة أن تميز بها نفسها؛ مكياج قليل لكنه يمكن يكشف عن شخصية صاحبته. الجسد أيضًا مفتاح لفهم المعنى وراء قصص القتل كما تحكيها صاحباتها خلف الأسوار والحراسة. وكما تحكي الأوراق الرسمية، وكما يدور على الألسن بين نزيلات العنابر، هناك دائمًا حكايات متناقضة عن نفس الحادثة. هناك خيال الاتهام، وخيال المتهم، وبينهما خيال يحاول فهم ما يجري. كل حكاية وراء السجن تكشف عن تفاصيل تاريخ سرى لتغيرات مصر في العشرين سنة الأخيرة. وتظهر التغيرات بوضوح في عالم المرأة؛ الأزياء، والموضة، وحركتها في المجتمع، وموقعها في العائلة، وأسعار متعتها، وتغطيتها أو الكشف عنها، حريتها أو قهرها، بيعها أو احترامها. يمكن أن تعرف ما حدث في المجتمع بعيدًا عن العناوين الصحفية والتحليلات الأكاديمية إذا نظرت إلى صور النساء، وتأملت في عالم القاتلات.
وهنا ظهرت… “الشيطانات”.
ا
شيطانة في الحذاء الحديدي
“الرجل الذي لم يعرف امرأة مختلة، لم يعرف نساء قط في حياته”. هذه الجملة فريدة، وربما هي التي قادتني دون تخطيط مسبق للبحث في حكايات نساء خارج صورة الجنس الناعم، الوجه الرقيق لخشونة الحياة، الكائن الرومانسي الضعيف. هذه الأوصاف والصور عادة ما تكون مملة، ليس فقط لأنها نمطية تسجن المرأة في صورة مختصرة، ولا لأنها تعتمد على كليشيهات خيال مثالي لا على واقع حقيقي، بل لأنها أساسًا صور تفتقر للإنسانية، وتضع المرأة في صورة على طريقة حذاء الحديد الذي كان الصينين يضعون فيه أقدام الفتيات كي تظل صغيرة؛ فالقدم الصغيرة علامة جمال الأنثى، ودونها تكون قبيحة خارج المقاييس المنتظرة للمجتمع. ورغم أنه عادة تخرج القدم من الحذاء الحديدي مشوهة، فإن العادة والنظرة الضيقة تراها جميلة في حجمها الصغير.
الجملة جاءت في مقدمة كتاب صدر في نيويورك. عنوانه بالإنجليزية “the most evil women in history”.. أقرب ترجمة له “أشهر شيطانات في التاريخ”. ويحكي عن 15 امرأة شغلت حكاية كل منهن التاريخ طويلاً. سفاحات، وقاتلات بالمصادفة.
تذكر المؤلفة شيللي كلين في المقدمة “يتمتع النساء أو يعانين (على حسب الزاوية التي تنظر بها إلى الأمور) منذ اللحظة التي أخرجت فيها حواء آدم من الجنة بلقب: الجنس الناعم، أو الجنس الأضعف، لذلك ففي كل مرة تخرج فيها المرأة عن طبيعتها، أو تتحول إلى قاتلة، سفاحة، تجد الناس يصرخون دائمًا (كيف استطاعت فعل شيء رهيب كهذا؟) لكن السؤال الحقيقي الذي يتردد في أذهانهم هو “كيف تستطيع امرأة فعل شيء كهذا؟ هذه وظيفة الرجال!”
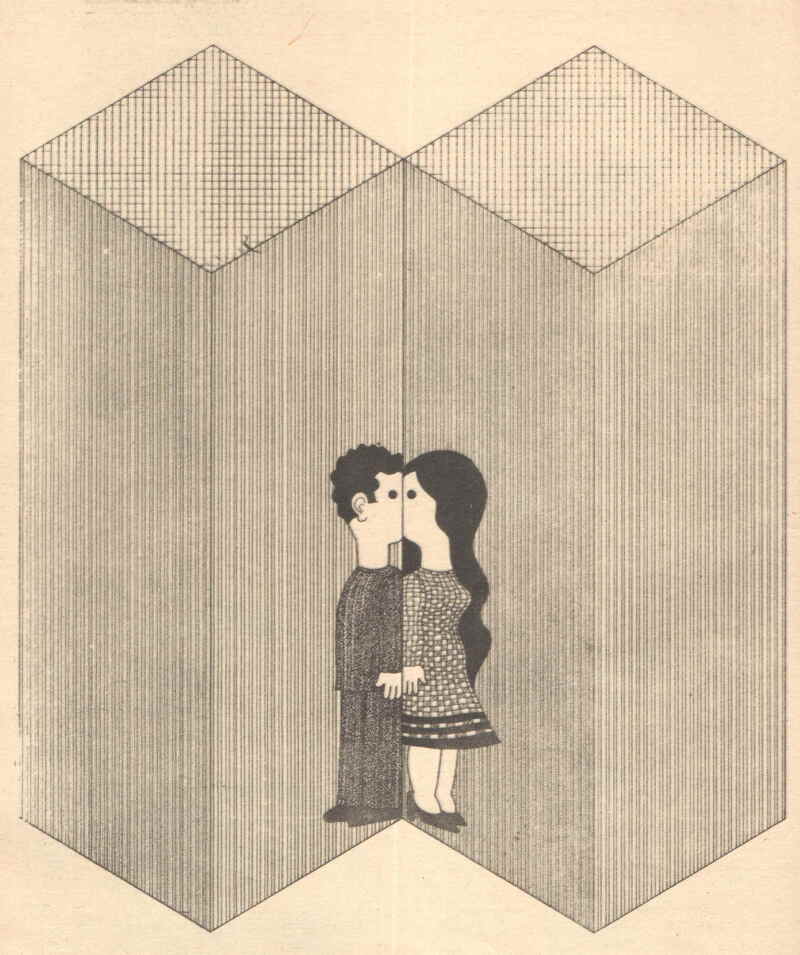
رسم الفنان حجازي في عدد خاص عن السينما و الفن: صباح الخير؛ ديسمير 1985*أرشيف مدينة
القتل بالليل والنهار
ربما هذا ما دفعني مرة أخرى إلى محاولة اللقاء بقاتلة، وتأمل ملامح وجها، وحركات يديها، وعلاقة جسدها بالمكان الذي تتحرك فيه. كنت أفكر: كيف تكون المرأة في لحظات العنف، هل تفكر في تاريخ طويل من قهر الرجال لها انتقامًا من قوتها الكامنة التي تخيفهم؟ الرجل عادة يقتل دفاعًا عن صورته كجبار متحكم، يمتلك قوة ظاهرة، لكن لماذا تقتل المرأة، هل تنتقم من قوة الرجل؟
الانتقام! فكرة لا بأس بها؛ لكنها غالبًا ليست دقيقة تمامًا. في كتاب “الشيطانات” إشارة إلى إحصاءات تخلص إلى أن “النساء يمثلن 2% من السفاحين في العالم، الأمر الذي يؤكد أن الناس ينظرون إليها على أنها ظاهرة استثنائية، ويجعل القضاة عندما يحاكمون أي امرأة بتهمة القتل يتعاملون معها دائمًا وأولاً باعتبارها مجنونة، أو غير قادرة على السيطرة على أفعالها، حتى وإن كانت ترتكب هذه الأفعال وهي في حالة صفاء ذهني، وإدراك تام”.
في عام 2000 صدرت في مصر دراسة إحصائية عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترى “كانت الأنماط الإجرامية لجرائم النساء تتركز، بنسبة كبيرة، في الجرائم الخلقية، وفي أنواع معينة من جرائم السرقة وتعاطي المخدرات والتشرد. إلى أن بدأت في خلال النصف الثاني من القرن العشرين- الذي شهد تغيرًا كبيرًا في الوضع الاجتماعي للمرأة في مصر- مسألة جرائم القتل التي ترتكبها نساء، تحظى ببعض الاهتمام باعتبارها مشكلة اجتماعية خطيرة. وخاصة أن ارتكاب جرائم القتل العمد أصبح يتم بشكل عنيف ومباشر وباستخدام الآلات الحادة والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء. كما أدى وقوع سلسلة من جرائم القتل العمد التي ارتكبتها نساء، وبخاصة تلك التي كانت ضحاياها من الأزواج، إلى كثرة التساؤلات”.
ماذا أصاب المرأة فجعلها تقدم على ارتكاب هذه الجرائم وبالطريقة البشعة التي بلغت، في أحيان كثيرة، حد التمثيل بالجثة وتقطيعها إربا أو الاحتفاظ بها بهدف التمثيل بها يوميًّا”. الدراسة التي أشرف عليها الدكتور أحمد المجدوب، اهتمت بجرائم قتل النساء خلال الفترة من 1990 إلى 1999 ورصدت بعض الأرقام المثيرة: المرأة اتهمت في 445 جناية قتل عمد من مجموع 6976، وهو ما يمثل 6,4%. تحتل محافظات الوجه البحري النسبة الأكبر (48,2%)، وتأتي بعدها محافظات الصعيد (35,2%) ثم محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس (15,3%).
50,5% من جرائم القتل التي ترتكبها النساء تتم نهارًا. 72,8% منها تتم داخل البيت؛ وهو ما يعني أنه غالبًا ما تكون بين القاتلة والقتيل علاقة قرابة أو معرفة.
أما وسائل القتل فنسبتها كالآتي: (27%) آلات حادة. (25,3%) أسلحة بيضاء. (17,1%) خنق. (11,2%) أسلحة نارية. (6,3%) حرق. (5,3%) تسميم. ويأتي بعد ذلك الضرب بالعصا (1,9%). وبقية الوسائل (3%).
وتترتب أسباب القتل في مستويات: الانتقام (29,9%). نزاع عائلي (14,8%). دافع العار (12%). الحصول على المال (10,5%). إخفاء جريمة (6,3%). مشاجرة (5,1%). تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة (4,4%). الدفاع عن النفس (3,8%). الغيرة (1,5%).
الأرقام مثيرة، لكنها مثل كل الإحصاءات صماء؛ لا تحكي الحكايات الحقيقية، ولا ترى إلا المؤشرات العامة، ولا يمكن أن تعرف لماذا تتحول المرأة إلى قاتلة، أو لماذا لم يعد غريبًا أن يتم القتل على يد أنثى متفجرة الأنوثة.. هل القتل هنا متعة.. أم إعلان عن قوة كامنة؟!
قاتلة تصلح العالم
يحكي كتاب “الشيطانات” عن ميرا هندلي؛ بطلة جرائم قتل المستنقعات، نفس الحكاية كانت موضع اهتمام الكاتب الأمريكي الشهير كولن ولسون في كتابه الذي صدر بالعربية بعنوان “التاريخ الإجرامي للجنس البشرى” وكان يشغله “كيف تحولت فتاة من حب الحيوانات الأليفة والأطفال إلى شريكة في ارتكاب جرائم قتل فظيعة كان ضحيتها أطفال”.
ميرا أحد أسوأ القاتلات في تاريخ إنجلترا؛ أُلقي القبض عليها في أكتوبر 1965 مع حبيبها إيان برادي بتهمة تعذيب واغتصاب وقتل عدة أطفال، وحكم عليهما لذلك بالسجن مدى الحياة، حتى ماتت عام 2002. ويقال إنه

ميرا هندلي قاتلة المستنقعات
لم يعد أحد في إنجلترا بعد 1966 يطلق على ابنته اسم “ميرا” إلا نادرًا، تمامًا مثلما صارت الأسر الالمانية ترفض إطلاق اسم “أدولف” (الاسم الأول لهتلر) على أبنائها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
كانت ميرا حين التقت إيان برادي مصادفة في 16 يناير 1960 نموذجًا لفتاة عاملة، موظفة على آلة كاتبة. لم تنعم بحياة عائلية مستقرة؛ فهي ابنة زواج مختلط كاثوليكي- بروتستانتي. أول رجل أحبته في الخامسة عشر من عمرها كان أصغر منها بعامين، كانت شابة قوية، عنيدة، بينما كان هو فتى خجولاً ضعيفًا هشًّا، وكانت العلاقة طبيعية ومثالية، تدافع عنه بإحساس خفي من الأمومة ويمنحها الحب، لذلك كان منطقيًّا أن تصاب بانهيار عصبي حاد عندما لقي مصرعه غرقًا. وهذه نقطة التحول في حياتها؛ فصارت فتاة بلا طموح، تعمل في وظيفة مملة تتركها بعد أقل من شهر إلى وظيفة مملة أخرى. تتسلى بتدخين الماريجوانا وشرب الخمور الرخيصة، حتى ظهر إيان برادي؛ الملهم الذي دخل معها في علاقة خلدها تاريخ الجرائم الدموية في العالم. شاب غريب المظهر، يركب دراجة نارية، ويرتدي جاكيت جلد مثل الهيبز المنتشرين وقتها في أوروبا كنوع من الاحتجاج على الحضارة الحديثة. وكان مهووسًا بالنازية (تعلم الألمانية حتى يقرأ كتاب هتلر “كفاحي” بلغته الأصلية). ويؤمن بأفكار الماركيز دي ساد (رمز السادية الشهير) الذي يرى أن كل المجتمعات البشرية فاسدة، وأن الحياة الإنسانية تافهة وعديمة الجدوى، وأن الطبيعة تهب وتسلب بعشوائية بلا تمييز، وأن البشر يعيشون في كون لا يحمل أي معنى، خلقته المصادفة المطلقة. هذه فلسفة سفاح يقتل ليحقق متعة كبرى ليصل إلى إحساس فريد بالتميز والقوة، ولأنه يرى العالم كريهًا تافهًا، وبرومانسية تخصه وحدة يستمتع بالقتل المجاني، بلا دافع.
ميرا كانت تبحث عن معنى لحياتها، أما برادي فكان يبحث عن مؤمن يستمع إلى فلسفته الخاصة. وفي مايو 1963 حدثها عن رغبته في قتل فتاة صغيرة، ورغم صدمتها كانت ميرا تدرك داخلها أنها ستنفذ ما يطلبه وتصبح شريكة، وربما ستستمتع بالقتل. الفتاة كانت تدعى بولين، عام 1963، تعرضت للاغتصاب قبل أن تقتل، وتوالت الجرائم. وذات مرة نام إيان وميرا ليلة كاملة فوق المكان الذي دفنت فيه إحدى الضحايا، بعدها شعرت ميرا أنها تجاوزت كل الحدود. هل شاركت فعلاً في عمليات القتل والتعذيب؟ أم أنها كانت تابعة لسفاح مهووس بالعنف كتب في مذكراته “الاغتصاب لا يعد جريمة، بل حالة من حالات العقل، والقتل هواية ومتعة لا تعادلها متعة”.

ميرا هندلي و إيام برادي زوجها وشريكها في القتل

ميرا هندلي وزوجها إيان رادي وشقيقتها الصغرى مورين
كولن ويلسون يرى الصورة من زاوية أخرى “ميرا صاحبة إرادة قوية، عكس الصورة الذهنية لدى الذكور عن الأنثى الرقيقة اللطيفة الناعمة، تتمتع بغرائز أنثوية عالية تتوق إلى تكوين أسرة، ومن المحتمل أن الانطباع الأول لبرادي عن ميرا أنها من الساقطات خشنات المظهر؛ وبعد أن اتضح له أن تلك الفتاة ذات الفك العريض مغرمة به، حل محل عدم الارتياح الغامض إحساس بالقبول، ولاحظ برادي أنها تبدو منحدرة من أصل ألماني، بدت في نظره واحدة من حارسات معسكرات التعذيب النازية، وبدأ يستمتع باللعبة الجديدة مثلما يتلذذ صياد السمك بمناوراته التي يقوم بها قبل اصطياده سمكة السلمون”.
شركة ريا وسكينة
ربما ميرا ابنة مجتمعات الرفاهية في أوروبا، حيث يمكن لظاهرة القتل المجاني (أو متعة القتل للقتل) أن تجد تفسيرها في فلسفات الاحتجاج والتمرد على ترتيب العالم بطريقة لا يحتملها أشخاص مثاليون، تقودهم الرومانسية أحيانًا إلى القتل. لكن الوضع في مصر مختلف؛ المرأة هنا تقتل إعلانًا عن الوجود؛ زوج يقهرها، أو يمنعها من اختيار حياتها، متع بعيدة عنها، مع عدم الاعتراف بأحقيتها في الشعور بلذة على أي نحو. هكذا تبدو الصورة المرعبة الآن: تقتل المرأة زوجها، ثم تمزق جسده بالساطور، وتضعه في أكياس بلاستيكية سوداء، وتلقي بها في أماكن مختلفة. وكأنها تقوم برحلة عكسية لأشهر ربات الفراعنة إيزيس التي قضت عمرها في محاولة جمع أشلاء جسد زوجها وحبيبها أوزيريس.
كانت ظاهرة “نساء الساطور والأكياس” قمة دراما التغيرات الاجتماعية التي أعقبت دخول مصر عصر جديد، بعد رحيل عبد الناصر، وحرب أكتوبر، وقوانين الانفتاح الاقتصادي، ومن امرأة قريبة من حدود الأرستقراطية تقتل زوجها في فيلا بكنج مريوط على أطراف الإسكندرية، إلى صعيدية رحالة في كفر فقير بقلب مدينة السويس. أصبحت كل واحدة “بطلة” بالمعنى الدرامي، حكايتها تشير إلى “حدث كبير في المجتمع”، فلم يكن المجتمع قد تعوَّد على فكرة المرأة “قتالة القتلة”. ولفترة طويلة ظلت ريا وسكينة وحدهما حالة استثنائية.
سمعت عن ريا وسكينة قبل أن أرى فيلم صلاح أبو سيف الشهير. أسطورة اتخذت رمزًا لتحوُّل المرأة إلى احتراف القتل، ثم استمتعت بكتاب صلاح عيسى “رجال ريا وسكينة” الذي يعيد فيه بناء الحكاية اعتمادًا على

سكينة بنت على همام في ساحة قسم اللبان

ريا بنت على همام داخل قسم اللبان
ملفات قضائية لم يهتم أحد بها. وقد اهتم صلاح عيسى بحكاية ريا وسكينة بالمصادفة، حين اكتشف أن المحامي في القضية كان أحمد أفندي المدني؛ الذي “ورد اسمه بوفرة في وقائع قضية الحزب الشيوعي المصري (عام 1920، أي قبل قضية ريا وسكينة بعام واحد). إذ كان أمينًا لصندوقه ثم سكرتيرًا عامًا له، وكان كل ما لدي من معلومات عنه أنه كان محاميًا متخصصًا في الدفاع عن العمال ويتسم بنزعة اشتراكية معتدلة” ولم يكن هذا هو الاكتشاف الوحيد؛ كان هناك أيضًا ملاحظة أن كل الرجال المحيطين بريا وسكينة كانوا ممن تطوعوا لخدمة جيش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى سعيًا للحصول على عمل أفضل في ظل شبح المجاعة التي عاشتها مصر خلال سنوات الحرب”.
لم يكن نشاط ريا وسكينة هو القتل للقتل، أو للسرقة، بل كان “الدعارة السرية”، فقد أدارتا، هما والرجال، أربعة بيوت “مجموعات من الداعرات اللواتي يبعن أجسادهن لكي يجدن القوت الذي يبعد عنهن، وعن أسرهن شبح الموت جوعًا. ريا كانت ترفض احتراف الدعارة، وسكينة احترفتها لفترة قصيرة وحصلت على رخصة رسمية بممارستها، لكنها سرعان ما اعتزلت لتحترف كلتاهما “تجارة الحرام”، ولكن بشكل غير رسمي وفي بيوت سرية. وفى حين كانت ريا تحتفظ بجسدها لزوجها وحده، وتأبى أن تنزل إلى حضيض ممارسة الرذيلة، بل وتستعلي على اللواتي تمارسنها من النساء، ولو كن يفعلن ذلك تحت إدارتها وبإشرافها، فإن سكينة التي كانت تشاركها نفس الآراء، كانت تمنح نفسها لمن تختاره من الرجال، بل وتنفق على عشاقها من نقودها دون أن تجد في ذلك شيئًا يكسر عينها، أو يقلل من مكانتها بين جيرانها”. الحكاية كما بناها صلاح عيسى تحتوي على مفاجآت كبرى، وتختلف عن الأسطورة التي احتفظت بها ذاكرة الناس من أكثر من 80 عامًا، ربما لأنها المرة الأولى التي تقود فيها امرأتان عصابة قتل وسرقة وبيع للمتع السرية. وبقي الاسم مع الأغنية التي ودعتهما بها نساء الإسكندرية مع الرقص والزغاريد فجر الأربعاء 21 ديسمبر 1921:
“خمارة يا أم بابين..
روحت السكارى فين؟”!
سميحة رقم 7

مجلة آخر ساعة1985*أرشيف مدينة
في سجن القناطر لم ألتق بملامح حادة وعنيفة مثل التي كانت لريا أو سكينة؛ بل كانت بطلات القتل بملامح مختلفة؛ هادئة وحزينة، حزنًا مستقرًا في مكان بعيد، لا تقترب منه إلا بحذر، وبرغبة في استعادة لذة الألم. مالت سميرة قليلاً لتبدو كأنها تسرُّ إلى بسرٍّ خاص، ثم قالت “أنا كنت جارة سميحة”.
سميحة؟!
كانت سميحة عبد الحميد نجمة الصحافة التي تشغل الرأي العام من ربيع إلى صيف 1985، وامتدت سنوات بعدها لتجاور أحداثا كبيرة مثل مفاوضات عودة طابا، أو بداية انتفاضة الحجارة في الأرض المحتلة، وإعلان تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو المعركة مع يوسف والي حول الصوبات الزراعية، واستجواب وتعذيب المتهمين في قضية الجهاد، واغتيال الرسام الفلسطيني ناجي العلي. كانت سميحة وقتها أشهر من الخطيب الذي كان موجودًا في الذاكرة رغم اعتزاله، ومن عادل إمام، ونادية الجندي، ومن رود خوليت لاعب هولندا الذي حقق معجزة الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم وفي أوروبا في نفس العام. وغطت أخبار سميحة أحيانًا على مشاريع المدن الجديدة التي أعلن عنها حسب الله الكفراوي وزير الإسكان، وعلى محاولات عودة ليلى مراد للأضواء. كانت سميحة ذروة سنوات عاشتها مصر، في ظل انفجار الغرائز المتوحشة لتكوين ثروات سهلة، وكان الفقراء والقريبون من الخطوط الأولى للطبقة الوسطى يفقدون الأمل في أحلام أكبر من لقمة العيش. في هذه السنوات كانت ديناصورات المال في فترة الحضانة، والشرائح الضعيفة تغلي على سطح من رغبات ممنوعة، مكبوتة، محرمة عليهم.
وفجأة قفزت سميحة للصفحة الأولى.
نظرت إلى يد سميرة التي أمسكت مطواة قرن الغزال، وأنهت حياة رجل أضخم منها مرتين ونصف؛ لونها مصبوغ من شمس سجن القناطر. هادئة وحزينة. لا تدرك في اللحظة الأولى أنها من عنبر “القتالات”، هل هذه خدعة المحترفات؟ تتحرك بتوتر أقل من الجميع، وعندما اختفت بعد الحوار، فكأنها تركت فجوة في المكان، مع أنها لا تملك ملامح لافتة للنظر، ولم تستعرض التفاصيل المدهشة من قصتها.
سينتمتران في قلب مسطول
سميرة التي همست بفخر عن جيرتها لسميحة ؛عاشت هجرتين؛ الأولى تقليدية من الصعيد إلى الشمال بحثًا عن رزق أوسع وخلق “جزر” كاملة في وسط المدن الكبرى (خاصة القاهرة والإسكندرية ومدن القنال). جاءت مع عائلتها إلى السويس، الأب يعمل في شركة البترول، لكنه لم يكن وحده، كان في “تغريبة عائلية”، ومن هذه العائلة تزوجت سميرة وعمرها 19 سنة. وهي واحدة من أربعة بنات وصلت ثلاثة منهن إلى التعليم الابتدائي وربما الإعدادي “الناس ماكنتش بتودي ولادها المدارس زمان” كان هذا تعليقها على فكرة التعليم. وهو تعليق ينقصه الإشارة إلى أنها تقصد بالناس الشرائح الفقيرة في الصعيد. وبالمقارنة، تبدو عائلة سميرة متقدمة، لأن عريسها لم يذهب إلى المدارس قط، تزوجته وعمره 27 عامًا، يكبرها بـ8 سنوات، وفي أزمة هجرة العمال والحرفيين المهرة إلى الخليج وجد لنفسه مكانًا في سوق العمل الحر كنجار باب وشباك “أرزقي”؛ باليومية أو حسب الطلب. وهو فرع أعلى بقليل من عمال التراحيل؛ أشهر مهن جيوش الهاربين من قلة الفرص والمال.
لماذا قبلت به وهي المتعلمة؟
“لأن تقاليد العائلة تقضي بألا تتزوج البنت من خارجها، وهو قريبي”. تزوجت سميحة بعد الهجرة الثانية التي كانت إجبارية بسبب الظروف السياسية التي أجبرت سكان مدن القنال الثلاثة على ترك بيوتهم والرحيل وفق خطط تسكين عمومية تنظمها الحكومة، أو خطط خاصة كما فعلت عائلة سميحة حين عادت إلى الموطن الأصلي في الصعيد.
السويس أقل محافظات القنال من ناحية فرص الحياة المريحة؛ فهي تتكون من أحياء فقيرة تشبه في هندستها الكفور في الأرياف، ولم تتغير إلا بعد حركة الإعمار فيما بعد حرب أكتوبر، التي نتج عنها أحياء جديدة متفاوتة المستوى أحاطت بالمدينة القديمة، وجعلت السكان القدامى محاصرين بالبنايات الجديدة وبساكنيها الباحثين عن فرصة في أنشطة ما بعد الحرب. ورغم قلة حظها، كانت السويس جاذبة للمهاجرين من الصعيد. ويبدو ذلك منذ أيام حفر قناة السويس التي جعلت من منطقة القنال “الموطن الثاني” للقادرين على تحمل العمل الشاق والحياة في ظروف صعبة. وكانت مراكز الجذب هي شركة تكرير البترول ومصنع السماد والميناء، بالإضافة طبعًا إلى النشاطات الاقتصادية الشرعية والسرية التي تقام على هامش تجمعات العمال والموظفين والفنيين. لكن السويس ظلت مدينة “جافة” لم تنل حظًا كبيرًا من نعومة الحياة في الإسماعيلية وبورسعيد. ربما لأنها حملت قدرًا كبيرًا من خشونة حياة المهاجرين الذين فرضوا نمط حياتهم في السويس أكثر من أي مدينة أخرى على خط القنال. لهذا لم تغير عائلة سميحة أفكارها ولا تقاليدها، وفرضت عليها زواج القبيلة الواحدة. وعندما وصلت إلى حائط مسدود بعد 9 سنوات من حياتها معه شعرت أنها “في متاهة بلا أبواب”.
سألتها: لماذا قررتِ فجأة أن تنهي حياة زوجك؟!
حكت: تريد أن تعرف ما حدث يومها.. أم تريد أن تعرف سنوات العذاب التي عشتها معه قبل تلك الليلة؟ هل تعلم أن الطب الشرعي أكد أنني لو تركته لكان مات وحده من جرعة زائدة من المخدرات!
لقد استقال من “صورة” الرجل ومهامه التقليدية في الصعيد، لم يعد يفكر في الإدارة المالية للبيت، وتركها لسميرة التي كانت تعمل في مستشفى نهارًا، وفي عيادة خاصة ليلاً. وكان دخلها يلبي احتياجات “بيت مفتوح.. وثلاثة أبناء، قبل الرابع الذي أنجبته في السجن”. لم يكن عمله منتظمًا “يومين أو ثلاثة في الشهر”، لكنه توقف حتى عن دفع مصروف البيت “كان يصرف كل دخله على المخدرات.. وفى المقابل كان يعتدي عليَّ بالضرب” وفي ليلة القتل “عاد إلى البيت في نفس حالته.. تظهر عليه آثار المخدرات.. وطالبني بإيصال أمانة كتبه على نفسه لصالح أبي بعد أن اقترض منه بعض الأموال. قلت له لا.. بدأ يضربني.. ودفعني إلى الأرض.. وحاول أن يكتم نفسي بيده.. وفتح على المطواة.. فأخذتها من يده وطعنته طعنتين.. قال الطبيب الشرعي بعدها أن هذه الطعنات أحدثت جرحًا طوله 2 سنتيمتر في القلب.. والله العظيم 2 سنتيمتر فقط.. لكن نتج عنه نزيف داخلي”.
كانت هذه ذروة السنة الأخيرة التي أحست فيها سميرة أنها “مخنوقة” من زوجها، وحاولت التخلص من الزواج نفسه، فلم تستطع، أولاً لأنه قريبها، وثانيًا لأنها مسيحية. ففكرت، وقررت قبل القتل إعلان إسلامها لتتخلص من الزو “الأبدي”، ولم تنجح، لأنها واجهت عاصفة عائلية هددتها بالحرمان من الأبناء، ومقاطعتها. فظلت على الصفيح الساخن تشعر بأن “الحب لن يطعمها هي وأطفالها”، وحتى الحب “لم يعد موجودًا مع رجل تسرقه المخدرات من كل شيء”، ولا يعرف التعامل معها سوى بالعنف. ويبدو أنها اكتشفت وهي في الثلاثين أن “سميحة هي الحل”.
جثة مجهولة في عام الجرائم الفاضحة

جريدة الجمهورية 26 مارس 1985 *أرشيف مدينة
في 26 مارس 1985 كانت سميحة خبر الصفحة الأولى؛ اكتشفت النيابة أنها بطلة قصة الجثة الغامضة التي عُثر عليها في السويس موزعة على سبعة أكياس بلاستيكية. الاكتشاف الأول للجثة كان في 24 فبراير 1985، لم يلتفت أحد للخبر الصغير بجوار مانشيتات ضخمة عن اجتياح إسرائيلي لجنوب لبنان، واستمرار حرب العراق وإيران، وسياسة الرئيس الأمريكي (الذي تندر البعض على أنه ممثل للأدوار الثانية في هوليوود) رونالد ريجان. هذه الأنباء الكبرى لم تكن بالتأكيد ذات تأثير مباشر على سميحة وعائلتها بجانب الحكايات التي تشغل الرأي العام في مصر مباشرة.
في ذاك العام، وبالتحديد في مارس، تصادف وقوع أشكال متنوعة من “الجريمة الجنسية”، أكثرها رعبًا كانت حادثة فتاة المعادي، التي اختطفها ستة رجال من خطيبها في ظلام الحي الهادئ وتناوبوا اغتصابها. في جريمة بشعة هزت الرأي العام وتحولت إلى مصدر رعب وتخويف للبنات من الخروج إلى الشارع. ومع أنها لم تكن أول جريمة اغتصاب فإن الظروف والملابسات جعلتها تشحن الجمهور الكبير بشكل غير مسبوق، حتى إن صحيفة “الأخبار” نشرت في نفس يوم اكتشاف الجثة الغامضة تحقيقًا كبيرًا بعنوان “حتى لا تتحول جريمة خطف البنات إلى ظاهرة”، ثم تصريحات لرجال الدين والقضاء: الإعدام هو العقاب الحاسم. هذا الشحن أحدث ضغطًا على القضاة الذين أصدروا بشكل سريع جدًا أحكامًا كبيرة على الجناة، فحصل خمسة من بين المغتصبين على الإعدام، ونفذ فيهم الحكم على الفور. وفي نفس الشهر عثر سكان البناية رقم 1 في ميدان سفنكس على جثة فتاة عارية في حديقة للبناية، وهي الحادثة المعروفة باسم الفتاة “سميرة مليَّان”، التي كانت مدعوة ليلتها إلى شقة الموسيقار بليغ حمدي. وأكملت حادثة سميحة سلسلة الجرائم الغامضة والمثيرة التي شغلت الرأي العام، وفتحت ملفات تتعلق بالجنس والعلاقات المركبة بين الرجال والنساء. وفجرت في المجتمع أسئلة حول الكبت الجنسي بسبب التقاليد المحافظة وتعقد شروط الزواج بين شباب الثمانينيات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أثارت خيال القارئ العادي تجاه ما يحدث في سهرات نجوم الفن والطرب؛ خصوصًا وأنه لم يمر شهر أكتوبر من العام نفسه إلا وكان الناس يتحدثون عن ماجدة الخطيب التي اتهمتها مباحث المخدرات بالاتجار والتعاطي، معلنة أنها وجدت في بيتها كيلو هيروين. وفي ديسمبر وجهت مباحث الآداب تهمة خدش الحياء العام لنجم الملاهي الليلية في السبعينيات أحمد عدوية، بسبب أغنية غناها في أحد ملاهي شارع الهرم. والمثير أيضًا أنه في نفس الصحيفة التي نشرت خبر العثور على جثة مجهولة كان يوجد خبر بداية التحقيق مع الرسام المشهور حسين بيكار الذي وصفته “الأخبار” (وكان أشهر رساميها) بأنه “زعيم التنظيم البهائي الذي ألقت مباحث أمن الدولة القبض عليه، وهم 39 شخصًا بينهم 12 سيدة”. وكان تفجير قضية “البهائية” غريبًا في ذاك التوقيت، خصوصًا وأن البهائية ليست تنظيمًا سياسيًّا وليست دينًا جديدًا، بل إحدى محاولات مثالية للجمع بين الأديان الثلاثة، وفي بعض الظروف التاريخية في مصر لم يكن هناك مانع لدى السلطات السياسية من التعامل معها، وهذا ما يفسر أن خانة الديانة في البطاقة الشخصية لبيكار مكتوب فيها: بهائي. هو إذن انتماء إلى عقيدة معترف بها بعد الستينيات، وهذا ما يجعل سؤال التوقيت مهمًا، والأقرب أن القضية كانت رسالة في إطار حرب الأمن مع الجماعات الإسلامية، ومضمون الرسالة: الدولة متدينة أيضًا.
هذا تخمين ربما، لكنه محاولة لفهم مناخ مشحون متوتر دينيًّا وجنسيًّا واقتصاديًّا، فهناك مع سميحة أخبار عن الحكم في قضية البنوك وتجارة العملة؛ وهي القضية التي اتُهم فيها سامي حسن علي، أشهر تاجر عملة قريب من مناطق النفوذ العلنية، وهي أول “جريمة اقتصادية منظمة” كبيرة تفتح الباب أمام سيل من جرائم نهب أموال البنوك (نواب القروض أشهرها)، ثم اللعب بأحلام الثراء السهل عند قطاعات كبيرة من العائدين من الخليج بمدخرات يريدون لها أن تتوالد دون تعب، فظهر شطار “توظيف الأموال”. وكانت صحف الأشهر الأولى من سنة 1985 مشحونة بصور كبيرة لأشرف السعد الذي كان حتى وقت قريب حامل حقيبة سامي حسن علي.
هل يمكن أن نرى “سميحة” نتاجًا غير واعٍ لكل هذه الفوضى الأخلاقية والمالية، وحتى السياسية، فهذا هو العام الذي انتهى بمذبحة صبرا وشاتيلا في بيروت. كما وقعت أحداث السفينة “أكيلي لاورو” التي اختطفها فدائيون فلسطينيون، ورست على شواطئ إيطاليا، وبمساعدة مصرية خرج الخاطفون في طائرة خاصة اعترضتها قوات أمريكية بأوامر من الرئيس الكاوبوي “ريجان” وأجبرتها على الهبوط، واعتقلت الخاطفين في انتهاك واضح لسيادة دولة مستقلة هي مصر. هذه الواقعة سببت “جرحًا” للرئاسة المصرية، خاصة حينما أعلنت المخابرات الأمريكية ببجاحة متناهية أنها عرفت خط سير الطائرة من خلال مراقبتها لتليفون الرئيس مبارك!
أين سميحة من المشهد، فإذا جمعته مثلما جمعت المباحث أجزاء جثة الزوج القتيل، سترى فيه لحظة فارقة لسنوات خرجت فيها غريزة تكوين ثروات متوحشة من بين أطلال زمن الرومانتيكية في السياسة والحب زمن “تماثيل رخام ع الترعة وأوبرا”. أين سميحة بين وحوش الجري وراء المال والنفوذ؟ ولماذا اتخذت هذه المكانة في تاريخ القاتلات رغم أن محكمة جنايات المنصورة حكمت يوم القبض عليها من منزل أخيها في الهرم بإعدام “شادية” التي قتلت زوجها (فبراير 1983) بمشاركة حبيبها، ثم ألقته على شريط القطار.. هل لأنها مارست فنون تقطيع الجثة بمهارة لافتة وكأنها تقطع أرنبًا أو دجاجة في مطبخ بيتها.. أم أن الضجة حول سميحة كانت نوعًا من بروباجندا الصحافة لإلهاء الناس بحكاية مرعبة تجذب الانتباه، وتشغل الناس عن التفكير فيما يحدث حولهم؟ كل شيء جائز!
البحث عن صورة رجل تحت السرير
نحن أمام حقيقة واحدة، وهي أن سميحة أصبحت ماركة مسجلة لجريمة تقطيع الأزواج ووضعهم في أكياس بلاستيكية. هذا ما فهمته حين همست سميرة “أنا كنت جارة سميحة”. ما الذي جعلها تتذكرها رغم أن هناك عامين بين “لعبة القتل” التي لعبتها كل منهما على طريقتها. ورغم أن سميحة كانت تعيش في “كفر سليم”، وسميرة في “عرب المعمل”؛ أي أنها لم تكن جارتها المباشرة، وسمعت عنها مثل كل الأهالي، وطاردت مثلهم أخبارها، كما اشتركوا جميعًا في تحويلها إلى “إبليس”. كل من يريد التأكيد على أخلاقه ويطمئن على مناخه العائلي يرجمها، حتى إن عائلات السويس ألغت اسم سميحة من سجلاتها، بل إن البعض تطرَّف وحرَّك في المحاكم قضية لتغيير اسم ابنته من سميحة إلى أي اسم آخر. سميحة أصبحت ملهمة النساء المكسورات، الحالمات بخلاص ما من جحيم رجل ضعيف أو نصاب. وفتحت أمامهن نوافذ في خيال الانتقام. هكذا بعدها بسنتين أيضًا تفجرت في فيلا هادئة بكنج مريوط قصة ناهد القفاص التي تحولت إلى فيلم “المرأة والساطور”. كانت سميحة تريد من زوجها أن يكون “رجلاً” حسب الصورة المرسومة في عقلها “الصعيدي”. كما حكت في التحقيقات “كنت أنتقم منه.. فقد عشت معه 15 عامًا لم أشعر خلالها بأنني زوجة يغار عليها ويحميها ويدافع عنها.. ترك لي حرية أن أفعل كل شيء وأي شيء كيفما أريد”.

الجمهورية بعد 3 أيام من اكتشاف الجثة؛ 29مارس 1985 *أرشيف مدينة
هذه صياغة الصحف لمقتطفات من أقوالها، ولا نعرف إن كانت هي بهذه البلاغة (الفخيمة التي تحافظ على صورة الرجل وتحتج على الحرية)، أم أنها تصورات الصحف التي هللت ونشرت صور سميحة، سابع امرأة تُعدم في مصر، وعشماوي يحيط برقبتها حبل المشنقة؟! المدهش أن هناك تناقضات في رواية الصحافة عن ليلة القتل وما بعدها، وإن اتفقت على أن القصة الرئيسية تدور حول العلاقة المريبة بين المثلث الشهير: الزوج والزوجة والعشيق. الزوج ابن خالتها، والعشيق صديقه الذي تعرَّف إليه في سنوات الهجرة من السويس إلى طلخا (على أطراف مدينة المنصورة) وعملا معًا في شركة السماد هناك. سميحة وأمين زواج عائلة واحدة كما تقول تقاليد جرجا؛ موطن العائلة الأصلي، حيث تمت إجراءات الزواج بين الشاب المعجباني حسب موديل السبعينيات (تسريحة محمود ياسين، وموديلات الأزياء الفضفاضة، والنظرات المكسورة الحالمة التي تشبه النظرة الشهيرة لعبد الحليم حافظ). أمين أحمد عليوة كان وسيمًا وفقًا لكتالوج الطبقة الواقعة في منتصف الطريق بين الفقر والستر. ومثله سميحة عبد الحميد أحمد (قصة شعر شادية ونظرات سهتانة على طريقة نيللي في الأفلام الرومانسية الحزينة، كما تظهر في صور الخطوبة). أمين قبل ليلة سميحة لم يكن هو نفسه الذي ينظر بالعينين الجاحظتين إلى كاميرا مصور العائلات ليسجل لحظة الشعور بالزهو الخادع في أول الشباب. كان قد أصبح رجلاً مهمومًا منهكًا، يلهث في الساعات الأولى ليلحق بطابور التوقيع في مصنع السماد بالسويس، ومنه يلهث إلى عمل إضافي كنجار مسلح. رجل تمتص قوته في تدبير مصاريف زوجة وخمسة أطفال، وفي الليل يحلم بمتعة الفقراء الوحيدة: الجنس.
تقول الحكاية المنشورة في الصحف إن هذه المتعة كانت المصيدة التي اصطادته بها سميحة “صباح الأربعاء، وقبل أن يغادر أمين فراشه فوجئ بسميحة بجواره تلاطفه، فرك عينيه، ما هذا؟ ماذا دهاها؟ حتى ليلة زفافها إليه لم تكن هكذا. لم يكن يعلم أن الأفعى قد قررت التخلص منه على طريقتها. تخلصت منه بصعوبة بحجة أنها ستعد الشاي له، وليترك ما يريده منها حتى يعود من عمله” (الجمهورية 26 مارس 1985). كان أمين قد تحوَّل إلى صورة مكررة من الأب المنهك الذي لا يجد سوى أولاده وزوجته يستعرض عليهم قوته. على الأولاد كان عصبيًّا؛ يضربهم لأهون الأسباب بقسوة (مستخدمًا السلاح الشائع في بيوت هذه الطبقة: خرطوم المياه). ومع زوجته كان يستخدم التهديد بالتجريس؛ فضيحة الغرام بصديقه من أيام طلخا، والذي عاد أكثر من مرة ووجده في البيت، ولم يواجهه أمين حسب رواية سميحة، واكتفى بالهجوم عليها؛ شتائم، واتهامات بأن أولادهما ليسوا من صلبه، وتهديد بالفضيحة. ويبدو أنها لم تقاوم الصديق كثيرًا وكانت تذهب معه مغيبة إلى ألعاب الهوى، وعند لحظة معينة قررت التخلص منه. الخيال الصحفي قال على لسانها في تفسير قرار القتل “لم يشعرني قط أنني امرأة، وكان ضعيف الشخصية، ترك صديقه يغازلني، ويدخل بيتنا وقتما يشاء، فتعلقت به وأحببته. لقد قتلته انتقامًا منه، ودفاعًا عن أنوثتي الجريحة”. وعندما سألها صحفي “الجمهورية”: كنت تخونين زوجك إذن؟ فأجابت بلسانها، أو بخليط منه مع خيال الصحفي “خيانتي بدأت بعد زواجنا بفترة وجيزة، حيث كنا نسكن جميعًا بشقة واحدة بعد تهجيرنا من السويس إلى طلخا، أنا وزوجي في غرفتين، وعاطف (العشيق) في غرفة، وشخص آخر بالغرفة الرابعة، وأصبحنا عائلة واحدة، حتى بعد رجوعنا إلى السويس كان يحضر لزيارتنا والمبيت عندنا”. هل أحبطها أمين المهزوز العاجز عن تلبية صورة الذكر الحامي المسيطر؟ أم خافت من الفضيحة؟
لا نعرف بالضبط. ما نعرفه أنها في الصور المنشورة مع أخبار الجريمة كبرت أكثر من ثلاثين عامًا عن صورة الخطوبة السعيدة. ونعرف أيضًا أنها خططت لجريمة كاملة: وضعت 12 قرصًا مخدرًا في كوب الشاي الذي أعدته بعد نوبة الإغراء الصباحية، وعندما بدأ تأثير المخدر، اهتزت قوى جسده بشدة، فظهرت مشاعر الافتراس لدى سميحة، حاول المقاومة، لكنها كتمت أنفاسه وخنقته بالإيشارب، فسقط على الأرض. فأخذت تلعنه وتركله وتصفعه على وجهه وتبصق عليه، ثم سحبته إلى تحت السرير، ونامت بهدوء حتى التاسعة صباحًا، وأرسلت الأولاد إلى بيت عمهم المجاور. وواجهت وحدها السؤال الذي لم تفكر فيه: أين أُخفي الجثة؟
تبدو المشاهد التالية لجريمة سميحة مثار اللعنة؛ هي مع جثة زوجها وحدهما في بيت تزدحم بين جنباته الذكريات القاسية. لا يشغلها سوى شيء واحد، ثم عثرت على الفكرة: سكين المطبخ الذي اشترته من السوق الحرة في بورسعيد، جنة البضائع الجديدة بعد الحرب. وبدأت رحلة التقطيع الماهرة (الطبيب الشرعي في البداية كان يعتقد أن القاتل إما أن يكون جزارًا أو جراحًا؛ فهناك احتراف في تشويه الوجه كي لا تُعلن ملامحه عن شخصية القتيل). وفي منتصف العملية حضر العشيق، وسأل: أين أمين؟ فأشارت إلى تحت السرير “إنه ينام هناك إلى الأبد”، أصيب الرجل بالذعر، وهرول من البيت يهلوس بكلمات غير مفهومة، لكنها لم تنتبه إلى صدمته، واستمرت في عملية التخلص من الجثة. وهنا رنَّ جرس الباب وكانت شقيقة أمين، فاستقبلتها بقوة أعصاب فولاذية، وأعدت لها الغداء، وسايرتها في الأحاديث العادية، وبعد أن غادرت، استكملت التقطيع بالحرفية نفسها، وهنا عادت ابنتها ميرفت (غالبًا اختاروا الاسم لتشبه النجمة المشهورة وقتها ميرفت أمين)، فأعطتها 60 قرشًا لتشتري لها أكياس بلاستيك من محل بجوار مسجد الأربعين، وضعت فيها 22 قطعة من جسد الزوج. وكانت تشرف على توزيع الأكياس بنفسها. وفي كل مرة تغير ملابسها وهي تلقي بمجموعة من الأكياس، ثم خرجت في الواحدة بعد منتصف الليل لتلقي الرأس وحدها في ترعة المغربي.
كانت هناك أكثر من علامة محيرة في القصة: هل حقًّا شاركت ميرفت (وكان عمرها في 1985 نحو 12 عامًا) مع الأم في مراحل التوزيع (الكيس الأول وجدته التلميذات في مدرسة إعدادية، هي مدرسة البنت كما قيل وقتها)؟ وكيف كانت الحالة المزاجية لسميحة في أثناء التحقيق، وحتى صدور الحكم الابتدائي في 18 نوفمبر 1985؟ هل كانت متزنة، لا تشعر بالندم، على وجهها نصف ابتسامة دائمة، أم كانت عصبية تشتم الصحفيين والمصورين وتحاول الاعتداء عليهم بالضرب؟ هل كانت تشعر بالخيانة عندما اعترف العشيق عليها، وكانت تتصور أنها نجحت في تنفيذ الجريمة الكاملة؛ فقد أشعلت النار في البيت لتوهم الجميع بأن زوجها هو الذي أحرقه؟ ولماذا أضربت عن الطعام واضطرت إدارة السجن إلى تغذيتها عن طريق حقن الجلوكوز؟ ثم لماذا طلبت فتح ملف التحقيقات والاعتراف مرة أخرى على حبيبها، أهو انتقام من نوع آخر؟ يبدو الأمر كذلك، بخاصة وأن وجه سميحة المحفور عليه تفاصيل كثيرة يترك الانطباع بأننا أمام مزيج من الظالم والمظلوم. من المجرم والضحية. وهذه هي الرسالة التي وصلت إلى سميرة بشكل غير واعٍ، مع أنها أخبرتني أنها “نادمة”، وأنها “كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس” وليست في وارد التخلص من زوجها، الذي تركت دينها لتتخلص منه، ولهذا ذهبت وسلمت نفسها للمباحث واعترفت، على عكس ما قال رئيس المباحث وقتها.
حين التقيتها كانت تبدو أكبر من عمرها بعشر سنوات؛ قضت في السجن 15 سنة و7 أشهر، ولا تعرف ماذا ستفعل إذا خرجت في العفو العام، فلم تر أولادها منذ فترة، وعائلتها ما زالت تحاسبها على القتل، وعلى تغيير دينها أيضًا. كانت وحيدة، وربما لها صديقة ترعى طفلها المولود في السجن، وربما ستعيد بناء حياتها من جديد، دون رجل. لم تكن تعرف، كما قالت نظرتها إلى فضاء بعيد وهي تتكئ بذراع على الطاولة، وذراعها الثاني تلم به الطرحة التي كشفت عن شعر رأسها الذي زحف اللون الأبيض عليه بقوة غريبة.






